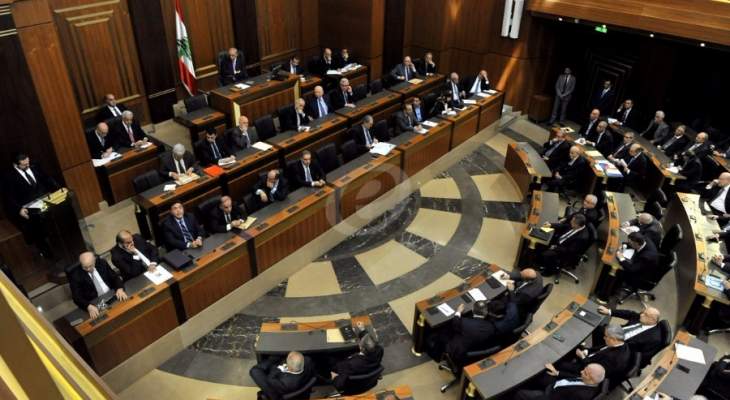أخيراً، بعد مماطلة طويلة لم تخلُ من المناورات المدمّرة والقاتلة، حُسِم الأمر، فوُلِد قانون الانتخاب الذي يعتمد النسبيّة وفق خمس عشرة دائرة، على أن يقرّه مجلس النواب الجمعة أو السبت لينشر في الجريدة الرسمية في ملحق خاص قبل 20 حزيران، الأمر الذي سيدفن عمليًا قانون الستّين وينهي مفاعيله، ويضع حداً لأيّ تهويلٍ بالفراغ وما شابهه.
واذا كان إقرار القانون بحد ذاته يعتبر انجازاً نوعياً كونه يعتمد النسبية للمرة الاولى في تاريخ لبنان، الأمر الذي دفع مختلف الأفرقاء للمسارعة إلى محاولة "تبنيه" لتوظيفه في السياسة لمصلحتهم، خصوصًا بعد كلّ السيناريوهات السوداوية التي وُضِعت موضع التنفيذ في الآونة الأخيرة، إلا أنه يبقى ناقصاً في ضوء العديد من الثغرات غير الهامشية التي تسجَّل على بعض تفاصيله...
إنجاز لمن؟!
بدايةً، لا شكّ أنّ ما تحقّق على صعيد قانون الانتخاب يُعتبَر إنجازًا يمكن وصفه بـ"النسبي" من وحي "النسبيّة" التي يطبّقها، والتي قد تكون، على علاتها في ضوء تقسيم الدوائر الحالي، والذي يرى البعض أنّه يفرّغها من مضمونها، المكسب الأكبر الذي لا يمكن نكرانه أو القفز فوقه. فهذه هي المرّة الأولى التي تُعتمَد فيها النسبية في لبنان، بمعزلٍ عن أيّ تفصيلٍ آخر، وفي ذلك نقطة قوة تسجّل لجميع المشاركين في صياغة القانون وإقراره، خصوصًا بعد أن وُضِعت النسبيّة، في وقتٍ من الأوقات، في خانة "الخطوط الحمراء" التي يمنع عبورها، بل ذهب البعض لحدّ "تحريمها" بالمُطلَق.
 وأبعد من ذلك، يشكّل إقرار قانون الانتخاب "إنجازاً" انطلاقاً من كونه وضع حداً لسيناريوهاتٍ خطيرةٍ بقي التداول بها قائمًا حتى اللحظة الأخيرة، قد يكون أقلّها مرارةً إجراء الانتخابات وفق قانون الستين الذي لم يبقَ أحدٌ في الدولة اللبنانية إلا ورجمه طيلة الفترة الماضية، وإن بقي البعض يمنّي النفس بالعودة إليه عند وقت الجدّ. أما أكثرها مرارةً، فقد
وأبعد من ذلك، يشكّل إقرار قانون الانتخاب "إنجازاً" انطلاقاً من كونه وضع حداً لسيناريوهاتٍ خطيرةٍ بقي التداول بها قائمًا حتى اللحظة الأخيرة، قد يكون أقلّها مرارةً إجراء الانتخابات وفق قانون الستين الذي لم يبقَ أحدٌ في الدولة اللبنانية إلا ورجمه طيلة الفترة الماضية، وإن بقي البعض يمنّي النفس بالعودة إليه عند وقت الجدّ. أما أكثرها مرارةً، فقد
يتعدّى تمديداً ثالثاً غير تقني للمجلس النيابي، ليصل إلى الفراغ الذي كان واردًا بقوة، رغم حساسيّته وخطورته، هو الذي كان سيأخذ البلاد والعباد إلى المجهول بكلّ حزمٍ وثقة.
ورغم كلّ المماطلة التي اتّسم بها أداء الطبقة السياسية إزاء قانون الانتخاب، والتي عكست في أكثر من محطّة استخفافًا بقضيّة بهذه الحساسة وصولاً لحدّ الإهمال المتعمّد، إلا أنّ المفارقة التي أمكن رصدها في الساعات الأخيرة كانت "تباري" الأفرقاء على "تبنّي" ما تحقّق بوصفه "انتصاراً" لهم دون غيرهم، بما يسمح لهم بتوظيفه في السياسة بما يناسبهم. وإذا كان رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري من أول المهلّلين، باعتبار أنّ القانون يعطي زخمًا لـ"العهد"، بعدما كانت "الخشية" عليه كبيرة من "انتكاسة" من شأنها نسفه عن بكرة أبيه، كان لافتاً في المقابل أنّ "التراشق" استمرّ بين "التيار الوطني الحر" و"حركة أمل"، حيث احتفل الأول بـ"البصمة" التي عاد ووضعها على القانون، فيما هلّلت الثانية لمنعها بعض مطالب "التيار" الطائفية برأيها. أما "حزب الله"، فكان "الانتصار" حليفه من جديد في قاموسه، باعتبار أنّ النسبيّة كانت خياره منذ اليوم الأول، فيما اعتبرت "القوات" نفسها "أمّ الصبي"، هي التي تريد أن يسجّل التاريخ أنّ "الحلّ السحري" أتى على أياديها.
ثغرات بالجملة...
وبعيداً عن "الطنّة والرنّة" المفتعلتين اللتين رافقتا إقرار القانون لأسباب واعتبارات سياسية بطبيعة الحال، يبدو أنّ كثيرين تناسوا أنّ مهمّة قانون الانتخاب العادل يجب أن تكون السماح بالتغيير الحقيقي، وبالتالي فالإنجاز، الذي أراد البعض أن يحتفي به وكأنّه "فردي"، يبقى ناقصًا إذا لم يرتقِ ليصبح جماعيًا، ويسجّل لصالح البلد ككلّ.
وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى سلسلة ثغرات، رصدها الخبراء الانتخابيّون في القانون العتيد، تقلّل من حجم "الانتصار"، لتجعله ربما "أفضل الممكن" في أحسن الأحوال، وعلى رأس هذه الثغرات حجم الدوائر الصغير نسبيًا، الأمر الذي يضعف من مفعول النسبية إلى أبعد الحدود، بل يجعل النظام بموجبه أكثريًا مبطناً بشكلٍ أو بآخر. وربطاً بذلك، يأتي الحديث عن وجوب أن تضم كل لائحة كحدٍ أدنى 40% فقط من عدد المقاعد في الدائرة الإنتخابية، وهي تُعتبَر نسبة قليلة تعطي مفعول النظام الأكثري، خصوصاً أنّه يمكن للأحزاب أن توزّع مرشحيها على أكثر من لائحة في هذه الحالة، كطريقة "احتيالية" على مفهوم النسبية.
ولا تبدو العتبة الانتخابية التي قرّر القيّمون على القانون أن تساوي الحاصل الانتخابيّ من الإنجازات، باعتبار أنّ العتبة لن تكون نفسها في كلّ الدوائر، بل ستتراوح بين 7 بالمئة في بعض الدوائر، وصولاً إلى 20 بالمئة في دوائر أخرى، مع الإشارة إلى أنّ العتبة يمكن أن يكون لها دور سلبي في استبعاد بعض الفئات من التمثل. في المقابل، فإنّ حصر الصوت التفضيلي في القضاء، وعلى الرغم من أنّه له إيجابيات، وإن كان البعض يرى أنّه بلا جدوى في ظلّ تصغير الدوائر، يأتي نتيجة حسابات طائفية بالدرجة الأولى، وهو يحوّل المعركة لفردية إلى حدّ كبير، ويُضعِف مفهوم اللائحة.
أما على صعيد الإصلاحات، فقد تبدو "الضحية الأكبر" للقانون، لجهة تغييب العديد منها، ولا سيما تخفيض سن الاقتراع وكذلك الكوتا النسائية، التي بقي التحفّظ قائمًا عليها من قبل العديد من الأحزاب، وصولاً لحدّ التهديد بنسف القانون من أساسه إذا ما أقرّت، كما أشارت بعض المعطيات، في حين أنّ أيّ تعديل لم يطرأ على مسألة تنظيم الانفاق الانتخابي في القانون العتيد، مع الابقاء على رسم الترشح. في المقابل، يسجّل للقانون أنّه أعطى مزيداً من الاستقلالية بشكلٍ أو بآخر لهيئة الإشراف على الانتخابات، التي نصّ القانون على ديمومتها، ولم تعد سلطة وزير الداخلية عليها مطلقة، كما أنّ إضافة ممثل عن المجتمع المدني إلى الهيئة، بمعزلٍ عن آلية اختياره، والتي لم تتحدّد بعد، تُعتبر أيضًا أمرًا إيجابيًا في المبدأ، يمكن البناء عليه.
بطولات استعراضية!
قد يكون التنافس على تحديد هوية "صاحب الفضل" في إنجاز القانون من أسوأ ما شهدته الساحة السياسية في الساعات الماضية. هكذا، خرج من "حركة أمل" من يقول أنّ دعاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ليلة القدر هو الذي دفع الأمور إلى الأيام، فيما كان مناصرو "التيار" يحصرون الفضل في رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجيّة وزير جبران باسيل، وهكذا دواليك.
من "حركة أمل" من يقول أنّ دعاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ليلة القدر هو الذي دفع الأمور إلى الأيام، فيما كان مناصرو "التيار" يحصرون الفضل في رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجيّة وزير جبران باسيل، وهكذا دواليك.
وعلى الأرجح، لا شيء يضاهي هذه "البطولات الاستعراضية" سوى "الحلّ الوسط" الذي نصّ عليه القانون لجهة انتخاب المغتربين، بعد "المعركة" بين بري وباسيل، حيث تقرّر إضافة ستّة نواب للاغتراب، كما أراد بري، في دورة، ثمّ إعادة احتسابهم ضمن الـ128، كما أراد باسيل، في دورةٍ أخرى.
ربما تكفي مثل هذه المفارقات للتأكيد على أنّ قانون الانتخاب ليس مجرّد تفصيلٍ في سياق التنافس القديم الجديد بين جميع الفرقاء على لقب "الرابح الأكبر"، لقبٌ لا يبدو أنّ لدى أحد الاستعداد للتنازل حبيًا عنه، ليذهب لمصلحة البلد، كلّ البلد...