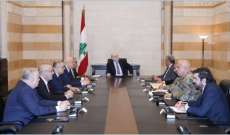كرّر العسكريون الروس شكواهم واستفساراتهم أكثر من مرّة حول تغاضي الأميركيين عن تسلّل مسلحي داعش من نقطة مراقبة أميركية قرب قاعدة التنف، التي ينتشر فيها جنود أميركيون، ونبّه الجانب الروسي الأميركيين إلى أن تحويل قاعدة التنف الواقعة على الحدود السورية الأردنية إلى «ثقب أسود» أمر مخالف للقانون الدولي، الذي اعتادت الولايات المتحدة انتهاكه منذ عقود، وأكد الروس أن نحو 600 إرهابي خرجوا بأسلحتهم على متن سيارات رباعية الدفع أمام أعين العسكريين الأميركيين من منطقة التنف باتجاه غرب سورية، وطالبوا بتقديم تفسير للتجاهل المقصود للمسلحين الذين ينشطون أمام أعين العسكريين الأميركيين.
بالقياس على مثال التنف، وفي مراجعة سريعة لكلّ الحروب التي بدأتها الولايات المتحدة خلال العقود الثلاثة الماضية، وراح ضحيتها الملايين من البشر الأبرياء، نتوصّل إلى نتيجة مبدئية وسريعة، وهي أن الأماكن التي حلّ بها الجيش الأميركي، مدّعياً محاربة القاعدة أو الإرهاب، أو القضاء على أسلحة دمار شامل، أو تعزيز حقوق الإنسان، أو إنقاذ الأقلّيات، وإلى ما هنالك من وصفات إعلامية جاهزة، أن هذه الأماكن بمجملها مليئة بـ«الثقوب السوداء»، وأنّه لو تمّت متابعة ودراسة حقيقية لما قام به الجيش الأميركي في كلّ هذه المناطق، لوجدنا أن الإرهابيين والمرتزقة في كلّ هذه المناطق قد نعموا بدعم أميركي من أجل تحقيق أهداف سياسية تخدم مصالح فئات النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة من مالكي مصانع السلاح وشركات المال والنفط والإعلام، أو لمصلحة الحليف الأول لها في العالم، وهو الكيان الصهيوني.
كيف نفسّر فجأة ظهور متشدّدين في ميانمار، والدعوة لإنقاذ حياة المدنيين هناك، وكيف نفسّر التحرّك المفاجئ للإسلاميين المتشدّدين في الفيليبين بعد أن استلم الرئيس الجديد رودريغو دوتيرتي زمام الرئاسة، الذي زار موسكو وعبّر عن توجهات لا ترضي الكاوبوي الأميركي؟ كما لم يعهد العالم أي وجود لتنظيم القاعدة في العراق إلا بعد الاحتلال الأميركي عام 2003، ولم تشهد العراق وسورية تنظيم ما يُسمّى «الدولة الإسلامية» إلا بتمويل وتسليح ودعم من الولايات المتحدة وتوابعها من مشيخات النفط العربي بهدف خلق كيان صهيوني وهّابي جديد يقوم بخدمة إسرائيل، ولولا تمكّن الجيش العربي السوري وحلفائه من دحر الإرهاب في مناطق عدّة، ربما، لما تمكّن أحد من تعرية ورؤية ما يحدث في قاعدة التنف وقد رأى العراقيون مثال ذلك.
حين شعر الأميركيون أن الجيش العربي السوري وحلفاءه يمكن أن يوجّهوا ضربة قاصمة للإرهابيين، ويفتحوا الحدود العراقية السورية لما فيه خير البلدين والشعبين، تدخّلوا وقصفوا وسمحوا لهؤلاء الإرهابيين بالتحرّك بحرّية وتحت غطاء وحماية أميركيتين.
إن دراسة معمّقة لما حدث في أفغانستان والعراق وليبيا وسورية واليمن تكشف، من دون أدنى شكّ، أنموذجاً متكرراً من استخدام أدوات إرهابية محلية بتمويل سعودي وتعبئة وهّابية، من أجل تحقيق مصالح جيوسياسية، ونهب ثروات، وفرض أجندات تخدم الإمبريالية والصهيونية، وتعمل على تحقيق أهدافهما في الإقليم والعالم، ولكنّ هذا الأسلوب المكشوف اليوم، الذي ينبئ عن نيات أميركية لإبقاء سيطرتها على جزء من سورية والعراق عبر خلق الدولة الكردية بديلاً من دولة داعش لتحقيق الهدف نفسه؛ أي خلق كيان متصهين يتحالف عملياً مع إسرائيل ويخدم مصالحها، ويترافق ذلك أيضاً ويتزامن مع سياسات في ملفات أخرى لا تمثّل ثقوباً سوداء فقط، ولكنها تعبّر عن تخبّط في مرحلة أفول حتمية لقطب عالمي استفرد بالعالم على مدى عقدين ونيّف، وفقد اليوم الكثير من رصيده السياسي والأخلاقي، وحتى المالي، ولم يبقَ لديه سوى القوة العسكرية والدعاية الإعلامية والمال النفطي السعودي التي تفقد تأثيرها شيئاً فشيئاً، والدارس لانهيار الإمبراطوريات، وأهمها انهيار الإمبراطورية الرومانية للكاتب المؤرخ غيبنز، يرى في ردود الفعل الأميركية، على نجاح محور روسيا وسورية وإيران والعراق والمقاومة في دحر الإرهاب، يرى فيها ردود فعل متشنّجة وغير عقلانية.
لا شكّ أن العدوّ الصهيوني يعيش اليوم أزمة وجودية بعد أن أثبت محور إيران وسورية ولبنان أنه محور مقاوم قادر على دحر أي إرهاب، وأنّ السياسة التفتيتية التي أمل بتنفيذها من خلال حرب الربيع العربي قد قلبت السحر على الساحر، فإذا هو أمام جبهة مقاومة أشدّ صلابة وأعمق خبرة وأكثر تصميماً على استكمال حرب التحرير ليس من الإرهاب فقط، وإنما من أي تبعية أو تنازل أو صفقة غير محمودة.
هنا يأتي انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو تعبيراً عن ردّة فعل متهوّرة على تنامي وعي الشعوب بأحقية الشعب العربي الفلسطيني في أرضه ودياره، وتنامي الغضب، وخاصةً في أوروبا، على الأساليب الصهيونية الاستعمارية المشينة بحقّ هذا الشعب الصامد الصابر، كما أن ردّة فعل الرئيس ترامب على الاتفاق النووي الإيراني لا تقلّ تهوراً غير محسوب النتائج، فإذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول: إن «إيران تنفّذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وهي تخضع لأشدّ نظام للتحقق النووي في العالم»، وإذا كانت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول: «لا سلطة لدى ترامب لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، ولا يحقّ لأي دولة إلغاء هذا الاتفاق»، وإذا كانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا أعلنت في بيان مشترك أن الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران يصبّ في مصلحتنا الوطنية، وإذا كانت الخارجية الروسية تقول: «العودة إلى فرض الأمم المتحدة لعقوبات على إيران غير ممكنة مهما كان الموقف الأميركي»، فكيف يمكن لترامب أن ينفّذ ما يريد؟ ولماذا يريد أن يلغي الاتفاق؟ فقط كي يبقى الكيان الصهيوني الوحيد الذي يمتلك الطاقة النووية في المنطقة، ولماذا يزيل ترامب الأعلام الروسية عن البعثات الدبلوماسية الروسية بعد أن انتهكت حكومته الحرمة الدبلوماسية للقنصليات الروسية منذ أسابيع؟ وهل قرّر ترامب أن يدفع بكلّ قوته كي ينقذ الكيان الذي يراه آخذاً في الغرق، ولم يحسب حساباً أن الغريق يُغرق من يحاول إنقاذه، أم إنها مظاهر حتمية لأفول مضطرب لقوة عُظمى تغيّر العالم من حولها من دون أن تتغير، وتغيرت الوقائع في كلّ المناطق التي تريد أن تفرض هيمنتها عليها؟
بدلاً من دراسة هذه الوقائع والتعامل معها بحكمة، تمضي إدارة ترامب في مخططاتها متجاهلةً أنه من المستحيل عليها أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، ولا شكّ أن صمود سورية والعراق واليمن وحلفائهم، وانتصارهم الميمون، بإذن الله، في هذه المعركة المصيرية للوجود القوميّ العربي، والتنسيق على هذه الجبهات، قد مثّل ضربة سبّبت عدم توازن للكيان الصهيوني الغاصب، والولايات المتحدة، ولكن، وبدلاً من الهدوء والإمعان في الخطوات المحسوبة، يزيدون من عدد الثقوب السوداء، ويخطّون سياسات متهوّرة لا يمكن لها أن تصل إلى المآل الذي يريدون.
إن تشجيعهم وحرصهم الخفيّ على خلق كيانات إثنية وعرقية في المنطقة، ليس إلا استمرار لسياسات الإنكار تلك، التي لا شكّ سوف يضطرون إلى التخلّي عنها عاجلاً أم آجلاً، ربما بعد أن يكونوا قد فقدوا كلّ أوراقهم حتى مع حلفائهم الأوروبيين.
أوليست كلّ هذه دلالات واضحة لأفول مضطرب لإمبراطورية الحروب التي تجاوزها الزمن؟