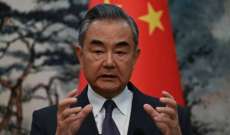لم يكن التدخل العسكري الروسي في سورية ليثير استغراباً أو دهشة للمراقبين ولمن يتتبّع دور روسيا ومكانتها وواجبها في صون أمنها الوطني والقومي ومجالها الحيوي وهي تتعاطى مع دول عظمى وكتل سياسية دولية لها وزنها الفاعل ومصالحها الإقليمية والدولية الاستراتيجية في العالم.
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ظهر عملاقان على الساحة الدولية تمثّلا بالولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي اللذين بدءا يرسمان سياسة العالم ويتقاسمان مراكز النفوذ، ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية وتراجع نفوذ وهيمنة الدولتين الكبيرتين بريطانيا وفرنسا وفقدانهما مستعمراتهما الموزعة في القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا وأميركا.
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية عرفت حرباً باردة دامت عقوداً عدة من الزمن، وشهدت تأسيس حلف شمال الأطلسي بزعامة الولايات المتحدة يوم 4 نيسان 1949، حيث أكدت المعاهدة على دور الحلف في حراسة حرية الدول الأعضاء وحمايتها من خلال القوة العسكرية، ولعب دوره من خلال الأزمات السياسية.
جاء الردّ على الحلف الأطلسي «الناتو» من قبل موسكو وذلك بالعمل على تأسيس حلف آخر يواجه التهديدات الناشئة عن أعضاء حلف الناتو، خاصة بعد انضمام ألمانيا الغربية إلى الحلف في 9 أيار 1955، حيث تمّ إنشاء حلف وارسو العام 1955، والذي حمل اسمه الرسمي «معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المشتركين» وقد استمرت هذه المعاهدة في عملها خلال فترة الحرب الباردة وحتى تفكك الاتحاد السوفياتي بعد حلّ الحلف رسمياً في شهر تموز العام 1991.
لغاية 30 أيار العام 1982 كانت هناك ست عشرة دولة… أربع عشرة دولة أوروبية ودولتان من شمال القارة الأميركية كندا والولايات المتحدة يتألف منها الحلف الأطلسي، ورغم تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء حلف وارسو واستقلال عشر جمهوريات عن الاتحاد السوفياتي السابق، نجد أنّ الولايات المتحدة ومعها الحلف، بدلاً من تخفيف زخم الحلف، تنتهز فرصة انهيار الاتحاد السوفياتي ووجود روسيا في وضع سيّئ سياسياً ومعنوياً ومالياً واقتصادياً لتندفع إلى الأمام في تعزيز دور الحلف والتفرّد بالقرار الدولي وضمّ دول أخرى إليه، وكان الهدف الرئيس من ذلك شلّ قدرات روسيا وتطويقها وعزلها شيئاً فشيئاً.
ففي يوم 12 آذار من العام 1999 ضمّ الحلف دفعة جديدة من الدول إليه، وهي: تشيكيا، المجر وبولندا، وهي الدول التي كانت سابقاً في حلف وارسو، ومن المفارقة أن بولندا التي حملت عاصمتها وارسو اسم الحلف العام 1955 أصبحت عضواً في الحلف الذي كان بالأمس عدواً لها.
لم يكتف حلف الناتو بهذا القدر من الدول، بل استمرّ في توسيع نطاق جغرافية الحلف وتواجده العسكري واللوجستي، ففي 29 آذار العام 2004 التحقت بالحلف سبع دول كان البعض منها في الاتحاد السوفياتي، والبعض الآخر يدور في فلكه عبر حلف وارسو، فمع انضمام كلّ من بلغاريا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا ارتفع عدد أعضاء الحلف إلى 26 دولة ست وعشرين واستمرّ توسع الحلف في 1 نيسان 2009 ليضمّ إليه ألبانيا وكرواتيا ليرتفع عدد دول الحلف إلى ثماني وعشرين دولة.
كان توسّع الحلف الأطلسي يثير هواجس روسيا ومخاوفها، خاصة بعد المحاولات الجارية لضمّ أوكرانيا وجورجيا اللتين تشكلان خاصرة روسيا، إلى الناتو، بالإضافة إلى ذلك اعتراض روسيا على نشر الدرع الصاروخية من قبل الحلف في بولونيا وعلى مقربة من روسيا، وكذلك التصدي لمحاولات الغرب التي اندلعت في البلدين والتي تلقت دعماً مكشوفاً من دول الحلف.
روسيا التي استعادت توازنها وتماسكها وقوتها وتجاوزت أزمة اقتصادية خانقة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وجدت نفسها في وضع يحتّم عليها أن تتصرف كدولة عظمى وبكلّ حزم بعد توسع الحلف الأطلسي والتهديدات التي تطرق أبواب أمنها الوطني والقومي ومجالها الحيوي في جورجيا وأوكرانيا، فكان عليها أن تردّ على هذه التهديدات من دون تردّد، وبحسم العمليات العسكرية العام 2008 في مقاطعتي اوسيتيا وأفخازيا مجهضة بذلك محاولات الحلف لضمّ جورجيا إليه، وما سرّبته أوكرانيا من نياتها الخاصة وعزمها الانضمام إلى نظام الدفاع الصاروخي الأميركي، وذلك عقب انسحابها من اتفاق يسمح لروسيا بتأجير بعض محطات الرادار في أوكرانيا، فبضمّ أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف، إنْ حصل، سيشكل استفزازاً وتهديداً مباشراً لروسيا، ويجعل الأسطول الروسي في البحر الأسود مهدّداً ومحاصراً في بحر سيكون خلال سنوات قليلة تحت رحمة حلف شمال الأطلسي.
توجّهات الحلف كانت تهدف إلى عزل روسيا وحصارها إلا أنّ هذه الأخيرة واجهت التحركات الأميركية بتعزيز علاقاتها مع الصين وتفعيل منظمة شانغهاي، كما سرّبت معلومات عن عزم موسكو نشر صواريخ «اسكندر» في سورية وإقامة قواعد عسكرية فيها، وتزويد إيران بأنظمة صواريخ متطورة، ونشر قاذفات في مناطق جغرافية قريبة من الولايات المتحدة كوبا وإعادة تشغيل محطة التجسّس والتنصّت الروسية على الأراضي الكوبية التي أوقف العمل بها العام 2001.
منذ العام 2008 وحتى اليوم وجدت روسيا نفسها أمام ثلاث محطات استراتيجية مفصلية لا يمكن التفريط بها أو تجاهلها وهي: جورجيا وأوكرانيا وسورية نظراً إلى ما تشكله كلّ دولة من الدول الثلاث هذه من أهمية أمنية واستراتيجية بعيدة المدى. لذلك كان الردّ الروسي الحاسم في جورجيا أمراً لا يمكن المساومة عليه، فالقرار الروسي العسكري في أوسيتيا وأفخازيا قلب المعادلات ولجم سياسات الحلف الأطلسي في جورجيا، أما في أوكرانيا فكان الردّ الروسي أكثر حزماً وأكثر إيلاماً للغرب، بعد أن تجاوز خطوط روسيا الحمر، فاستعادت موسكو القرم وقاعدتها البحرية العسكرية فيها لتقول للعالم كله وللحلف الأطلسي بالذات أنّ البحر الأسود هو المجال الحيوي والاستراتيجي لروسيا التي لها فيه القرار والكلمة الفصل.
وها هي روسيا اليوم تكشّر عن أنيابها مرة جديدة في سورية التي ترى فيها ما رآه قبلها بطرس الأكبر وكاترين الثانية من أهمية استراتيجية لحديقتها الخلفية الجنوبية، والتي وصفت سورية بمفتاح البيت الروسي، هي سورية التي يدرك الغرب والولايات المتحدة بالذات أهميتها وأهمية موقعها في هذا الشرق، وهو ما عبّر عنه صراحة وزير الخارجية الأميركي جون فوستر دالاس في الخمسينيات من القرن الماضي عندما وصف سورية بقوله: «إنها موقع حاكم في الشرق الأدنى… إنها أكبر حاملة طائرات ثابتة على الأرض في هذا الموقع الذي يشكل نقطة التوازن تماماً في الاستراتيجية العالمية، وهذا الموقع لا يجازف به أحد ولا يلهو به طرف، من امتلكها امتلك مفاتيح المشرق وسيطر على العصب الذي يصل المشرق بأوروبا، وكانت له الكلمة الفصل في تدفق الغاز والنفط من شرايين المشرق إلى مستهلكيه في أوروبا وأميركا بأقرب الطرق وأيسرها من سواحل المتوسط إلى مستهلكيه مباشرة».
لقد أدركت روسيا ما يحضّر لسورية الموقع والدور من قبل الغرب وبعض الدول الإقليمية التي تدور في فلكها التنظيمات المسلحة التي احتضنت إرهابيين من أنحاء العالم ومن جمهوريات تابعة للاتحاد الروسي من أجل إسقاط الدولة السورية، وإسقاط المنطقة كلها في ما بعد وجرّها إلى مناطق النفوذ الغربي المباشر، والهيمنة عليها وتطويق روسيا أكثر فأكثر وشلّ حركتها وقدرتها وتحجيمها بالقدر الذي يريده الغرب لها.
ليس من السهولة ترويض الدب الروسي، خاصة إذا ما استُفِز، فسرعان ما يثور وينتفض ويضرب ضربته القاضية عندما يجد أنّ الطوق يقترب منه، مهما كلفه ذلك ومهما كانت النتائج والتبعات.
يبدو أنّ الغرب يعي ذلك جيداً، ويعرف حقيقة ما تقوم به موسكو اليوم في سورية وغيرها، وهو الذي بسياساته الخبيثة لن يتردّد للعمل على جرّها إلى حرب استنزاف يريدها لها.
لقد كشفت الضربة الروسية والعمليات العسكرية وما أنجزته وحققته خلال أيام قليلة نفاق الغرب وتحالفه الدولي في مواجهة الإرهاب، وأسقطت النقاب عن مهزلة قام بها التحالف الدولي وروّج لها ليثبت على أرض الواقع أنه لا يريد القضاء على الإرهاب، بل يريد حرب استنزاف طويلة لسورية تؤدّي في نهاية المطاف إلى تفكيك سورية وتدمير شعبها ومكوناتها واقتصادها وحضارتها وإدخالها في ما بعد إلى بيت الطاعة الأميركي، فمن احتضن الإرهاب ورعاه وموّله وسلّحه ودرّبه ودعمه هو أبعد ما يكون عن الصدقية في مواجهته واجتثاثه.
القرار الروسي الذي جاء في موعده، يترجم ولا شك موقفاً شجاعاً حازماً لا رجعة عنه، فعندما يهدّد الإرهاب ومن يدعمه المجال الحيوي لروسيا وأمنها الوطني والقومي ومصالحها الاستراتيجية، ويهدد أيضاً حلفاء روسيا وأصدقاءها، عندئذ لا يبقى أمام موسكو إلا قرار القوة تستخدمها على الأرض وتقف بكلّ شجاعة ومسؤولية بجانب الأصدقاء والحلفاء لمواجهة الإرهاب والإرهابيين ومَن يقف خلفهم، وتضع حداً لسياسات الأحادية الدولية وغطرستها، والتي عبثت بالعالم لفترة من الزمن كانت من أكثر وأسوأ الفترات استبداداً وبشاعة وقذارة وقهراً.