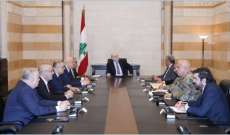تتضارب الآراء بشأن عبارتي "الدولة العلمانيّة" و"الدولة المدنيّة"، حيث يعتبر البعض أنّهما يعودان إلى مبدأ واحد ولوّ مع بعض التفاصيل المُختلفة، في حين يرى البعض الآخر أنّه في "الدولة العلمانيّة" يُمكن أن يكون الحُكم بيد العسكر والجيش بينما في "الدولة المدنيّة" كل المؤسّسات يجب أن تخصع لأشخاص مدنيّين. حتى أنّه تُوجد آراء مُتشدّدة تعتبر أنّ تعبير "الدولة المدنيّة" ما هو إلا تجميل لواقع "فصل الدين عن الدولة" في "الدولة العلمانيّة" عبر إستخدام كلمة مُلطّفة ولا تحمل الأحكام السلبيّة المُسبقة من جانب المُتديّنين تجاه العلمانيّة. وفي مُطلق الأحوال، وبعيدًا عن هذه التفاصيل، إنّ "الدولة المدنيّة أو العلمانيّة" هي دولة تحمي نظريًا كل أعضاء مُجتمعها، بغضّ النظر عن إنتماءاتهم الدينيّة والقوميّة والعرقيّة والفكريّة، وهي دولة تُقدّم مبدأ المُواطنيّة على ما عداه، مع ضمان الحُقوق والواجبات نفسها لكل أفراد المُجتمع بدون أي إستثناء. وهذه الدولة تفصل بالتأكيد بين الدين والسياسة، لكنّها تحترم وتكفل حريّة المُعتقد الديني لكل المُتديّنين بمُختلف طوائفهم ومذاهبهم، وكذلك حريّة غير المُتديّنيّين وحتى المُيول الإلحاديّة. فهل يُمكن تطبيق مبادئ "الدولة المدنيّة" في لبنان لحلّ المشاكل الطائفيّة والمذهبيّة المُزمنة؟.
بداية، لا بُد من الإشارة إلى أنّه على المُستوى الإقليمي، وبعد سُقوط مجموعة من الحُكّام الدكتاتوريّين في العراق واليمن وليبيا ومصر وتونس، تظهّر التعصّب الطائفي والمذهبي أكثر فأكثر في هذه الدُول بدل الإتجاه نحو الأفكار العلمانيّة والمدنيّة، مع تبريرات جاهزة تُحمّل المسؤوليّة لمُؤامرات خارجيّة لتقسيم شُعوب المنطقة تارة، ولمصالح خاصة لبعض الزعامات المحليّة والدول الإقليميّة طورًا. وفي كل الأحوال، بقي التعصّب الأعمى مُتفوّقًا على المُواطنيّة وعلى حُقوق الإنسان، في مُختلف الدول التي شهدت "ثورات"، وجرى مثلاً إضطهاد المسيحيّين في العراق وتهجيرهم، ونقل السُلطة عمليًا من يد القيادات السُنيّة إلى يد القيادات الشيعيّة. كما جرى مثلاً الإضاءة على الإنقسامات العُرقيّة بشكل كبير، إن في العراق أو في سوريا أو غيرهما من الدول، وأخذ الإنقسام في اليمن أبعادًا بخلفيّات دينيّة أيضًا، مع توسّع نُفوذ حركة "أنصار الله"، ومُواجهتها من خُصومها على هذا الأساس. حتى في سوريا، حيث لم يسقط الحُكم العسكري للشخص الواحد، فإنّ السبب لم يكن فوز الأفكار العلمانيّة على الأفكار الدينيّة المُتعصّبة، بل تفوّق النهج السياسي والعسكري الذي إعتمدته روسيا على ذاك الذي إعتمدته الولايات المتّحدة الأميركيّة، وخُصوصًا نتيجة تفوّق الميليشيات الشيعيّة التي إستقدمت من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان وغيرها من الدول، على الجماعات السُنّية المُسلّحة التي جرى جلبها من مُختلف دول العالم في مُحاولة لإسقاط حُكم الأقليّة العلويّة. حتى أنّ تركيا التي كانت تُمثّل إستثناء ضُمن الدول الإسلاميّة الإقليميّة، في توجّهها العلماني، راحت في السنوات القليلة الماضية، تعود تدريجًا إلى ثقافة شعبها الدينيّة. ولولا مصالحها الإقتصادية والسياحيّة، لكان جرى إسقاط ما تبقى من علمانيّة موروثة من زمن مصطفى كمال أتاتورك.
عقبات بالجملة...
في لبنان، التناقض فاضح بين الدعوات النظريّة لتعزيز الأسس المدنيّة للدولة، والتطبيق العملاني الذي ضاعف من الإنقسامات الطائفيّة والمذهبيّة. والتموضعات الطائفيّة والمذهبيّة لم تكن بهذا القدر من التعصّب، حتى في عزّ الحرب اللبنانيّة، على الرغم من كل الكلام الحالي المعسول عن الوحدة الوطنيّة وعن التعايش. ومفهوم المواطن اللبناني تراجع إلى مُستويات مُتدنّية، في مقابل تقدّم الإعتبارات الطائفيّة والمذهبيّة. والعقبات أمام تحوّل لبنان إلى دولة علمانيّة أو مدنيّة مُتعدّدة، وأبرزها:
أوّلاً: النُفوذ الديني لمُختلف الطوائف والمذاهب ضُمن بيئاتها المُصغّرة، كبير جدًا، ولا يُمكن إزالته بشحطة قلم، خاصة أنّه يُوجد 15 قانونًا مُنفصلاً للأحوال الشخصيّة مع إختلاف الطوائف المذاهب، للبتّ في قضايا الطلاق ورعاية الأطفال والولاية على القاصر والملكيّة وغيرها الكثير.
ثانيًا: نسبة الأشخاص المُستعدّين للمُوافقة على زواج مُختلط، أو الذين يُمارسون الإنفتاح الديني الحقيقي، مُتدنّية جدًا نسبة إلى الأشخاص المُصرّين على تقوقعهم داخل طوائفهم ومذاهبهم. فالكثير من اللبنانيّين يصرّون على التمسّك بتمايزهم الطائفي والمذهبي، على المُستوى العام والخاص على السواء، والإثباتات على ذلك لا تُعدّ ولا تُحصى، من الكلام الذي يُحكى في الجلسات الخاصة داخل الجُدران الأربعة، وما يتمّ تسريبه بين الحين والآخر من كلام جارح بحقّ طوائف ومذاهب معيّنة، مُرورًا بالشعارات التي تُردّد في المناسبات السياسيّة والدينيّة المُغلقة، وحتى خلال الكثير من المُباريات الرياضية، وُصولاً إلى المُطالبات العلنيّة بحفظ حُقوق هذا المذهب أو ذاك.
ثالثًا: عشرات الترقيات والتعيينات والتوظيفات توقّفت في السنّوات الماضية، بسبب إصرار مُتبادل من مخُتلف القوى والقيادات السياسيّة بسبب خلافات على مُستوى التوازنات الطائفيّة والمذهبيّة الدقيقة والحسّاسىة، في دليل حاسم على تمسّك الجميع بحُقوقه الدينيّة على حساب تقدّم مبدأ المواطنيّة. وفي السياق عينه، يدخل تمسّك السُنّة بمختلف إنتماءاتهم السياسيّة بسُلطات رئيس الحكومة، وإصرار الشيعة على مُشاركة الموارنة والسُنّة في التوقيع على القوانين عبر السيطرة على وزارة المال، وتحسّر المسيحيّين على سُلطات تنفيذيّة سُحبت منهم، إلخ...
رابعًا: في الدولة المدنيّة، يُمنع الجمع بين السُلطة الدينيّة والسُلطة السياسيّة، لأنّ هذا الأمر يجعل الشخص المعني فوق القانون وفوق المُحاسبة، لأنّه محميّ بعباءة دينيّة. فهل يُمكن تطبيق ذلك في لبنان؟، حيث يقود مثلاً الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله أحد أكبر وأقوى الأحزاب، وهو مُستثنى-بسبب عباءته الدينيّة، من التهجّم السياسي القاسي الذي يتعرّض له أغلبيّة المسؤولين الحزبيّين والسياسيّين؟!.
خامسًا: إنّ المُطالبة بإلغاء الطائفيّة السياسيّة، تنفيذًا لما ورد في أحد بنود "إتفاق الطائف"، ما هي في الواقع إلا دعوة مُبطّنة لأنْ تحكم أغلبيّة عدديّة من طائفة معيّنة ومن مذهب معيّن أقليّة من طائفة مُغايرة ومن مذهب مُغاير، لأنّ الطائفيّة والمذهبيّة هي اليوم في أعلى مُستوياتها في النُفوس، وقراءة تحليليّة مُبسّطة لوجهة تصويت اللبنانيّين خلال الدورة الإنتخابيّة النيابيّة الأخيرة هو خير دليل مادّي ملموس على ذلك.
سادسًا: المُضحك–المُبكي أنّ التذكير بين الحين والآخر بالتفاوت العددي بين المسيحيّين والمُسلمين، والذي يزداد إتساعًا، أكان للقول إنّه جرى إيقاف العدّ أو لتوجيه تهديدات مُبطّنة بأنّ المسيحيّين سيفقدون إمتيازاتهم الحاليّة ما لم يُوافقوا على إلغاء الطائفيّة، ما هو إلا إثبات بتمسّك مُردّدي هذا الكلام بخلفيّاتهم الطائفيّة والمذهبيّة، بحيث ينظرون إلى شريكهم في الوطن من منظار دينيّ وليس من منظار وطنيّ لا يُميّز بين مواطن وآخر بحسب طائفته ومذهبه.
في الخُلاصة، قبل الحديث عن أيّ إلغاء للطائفيّة السياسيّة أو عن أي توجّه لدولة مدنيّة، يجب الإرتقاء أوّلاً بالتفكير العلمانيّ على مُستوى النُفوس والتربية، والخروج من الدوائر الدينيّة المُتعصّبة، والتخلّي عن الإمتدادات الطائفيّة والمذهبيّة العقائديّة الخارجيّة. وفي كل الأحوال، من الضروري أن يكون توجّه أي مُجتمع نحو العلمانيّة مُتأتيًّا من قناعة ذاتيّة إراديّة، وليس مفروضًا فرضًا، وفي لبنان–وحتى إشعار آخر، إنّ الأغلبيّة الشعبيّة هي مع التمسّك بامتيازاتها الدينيّة، بغضّ النظر عن إيجابيّة أو سلبيّة هذا الأمر.