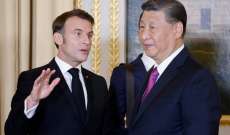خلال الشهر الماضي، شهد العالم العربيّ ما يمكن وصفه بأنّه النسخة الثانية من "الربيع العربي"، نسخة أطاحت حتى الآن برئيسيْن عربييْن جديديْن، هما الرئيسان السوداني عمر البشير والجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بعد "حراك" في الشارع رفضاً للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المأزوم.
وعلى غرار المواسم السابقة من "الربيع العربي" التي لم تكن نتائجها على قدر الآمال والتوقعات، بعدما تحوّلت ساحاتها من "الربيع" إلى "الخريف"، تارةً بسبب انتقال السلطة من نظامٍ "ديكتاتوري" إلى آخر لا يختلف عنه سوى بالاسم، وطوراً بسبب "انقلاب" المعطيات دراماتيكياً على الأرض، وتحوّل "الحراك" إلى مواجهات دموية ثقيلة تحت عنوان "الصراع على السلطة".
وفي حين تكثر الأسئلة عن "التالي" على الأجندة، ثمّة من بدأ يشير بالإصبع إلى الواقع اللبناني الذي لا يبدو مريحاً، خصوصاً في ضوء ما بات شبه مُعلَن، عن إجراءات "قاسية" وغير شعبيّة، تتجّه الحكومة إلى إقرارها من خلال الموازنة، وهو ما أدّى تلقائياً إلى خروج تظاهرات واعتصامات، وسط دعوات إلى تصعيد، حتى الوصول إلى العصيان والانتفاضة وربما أكثر من ذلك...
الواقع مختلف...
بدايةً، لا شكّ أنّ الواقع اللبناني مختلف عن كلّ الدول التي حطّ فيها "الربيع العربي"، سواء في موسمه الأول، من تونس ومصر إلى ليبيا واليمن، أو الثاني، في السودان والجزائر، أو ما بينهما، على غرار سوريا، التي تحوّلت إلى ساحة حربٍ عنيفة لا يُعرف متى أو كيف يمكن أن تنتهي.
ولعلّ نقطة الخلاف الأساسيّة بين هذه الدول ولبنان تتمثّل بدايةً في مبدأ الديمقراطية، ولو اعتبر كثيرون أنّها في لبنان شكليّة ليس إلاّ. وخير دليلٍ على ذلك أنّ تداول السلطة معمولٌ به في لبنان، خصوصاً على مستوى الرئاسة الأولى، إذ يتغيّر رئيس الجمهورية كلّ ست سنوات، وكذلك في رئاسة الحكومة، في حين أنّ كلّ الدول التي حصل فيها حراك، كانت تعاني من "ديمومة" الرئيس، الذي يبقى في سُدّة السلطة مدى الحياة، ولعلّ المثال الجزائري "فاقعٌ" في هذا المجال، حيث بقي بوتفليقة مصراً على البقاء في موقعه، بل رافضاً للتخلي عن فكرة الترشّح إلى الانتخابات المقبلة، على رغم أنّه يعاني منذ سنوات طويلة، بعد إصابته في العام 2013 بجلطة دماغيّة جعلته نادر الظهور، وعاجزاً حتى عن الكلام بيسر.
أما نقطة الاختلاف الثانية والأهمّ، فتتمثّل بطبيعة النظام اللبناني ككلّ، إذ فيما تعاني مختلف الأنظمة المذكورة ممّا يسمّى "احتكار السلطة" من قبل حزبٍ واحدٍ، هو حزب الرئيس بطبيعة الحال، والذي يتحكّم بالشاردة والواردة في البلاد، يختلف الواقع في لبنان، ولو اعتبر كثيرون أنّه هو الآخر ضحية نظام استبداديّ واحد، هو النظام الطائفي. إلا أنّ هذا النظام هو في نهاية الأمر عبارة عن تحالفٍ بين "زعماء" ينتمون إلى مختلف الطوائف والأحزاب، هم جميعاً نتيجة هذا النظام، ويتمسّكون به لأنهم يدركون أنّ مصلحتهم ببقائه واستمراره، بل ديمومته.
تظاهرات محدودة؟!
اختلاف الواقع اللبناني عن ذلك العربيّ العام، بل اعتبار كثيرين أنّ الديمقراطية اللبنانية يفترض أن تمثّل "نموذجاً" يحتذى في المنطقة، لا يكفي للقول إنّ رياح "الربيع العربي" لا يمكن أن تصل إلى لبنان، خصوصاً في ضوء ما بدأ يُحكى عن إجراءات "غير شعبية" يفترض أن تتّخذها الحكومة اللبنانية، لمواجهة واقعٍ اقتصادي واجتماعي لا يختلف عن ذلك الذي تعانيه الدول العربيّة، ولا يبشّر بالخير.
وإذا كانت التسريبات بدأت على طريقة "جسّ النبض" منذ ما قبل تشكيل الحكومة، من خلال الحديث عن إجراءات تقشفيّة تعتزم الحكومة اللجوء إليها، في إطار تنفيذ مقرّرات مؤتمر "سيدر" من ناحية، وفي إطار تفاقم الخشية من الانهيار الاقتصادي الحتميّ، فإنّ أحداً لم يأخذ هذه التهديدات على محمل الجدّ، بدليل الاحتفالات الشعبيّة التي انطلقت عند تشكيل الحكومة، وكأنّ الأمر إنجازٌ غير مسبوق.
هذا الأسبوع، بدأت الأمور تأخذ منحى مختلفاً، مع الحديث عن إنجاز الموازنة، وتضمينها إجراءات غير شعبيّة ستطال أصحاب ذوي الدخل المحدود والمتوسط قبل غيرهم، بل ستطيح بسلسلة الرتب والرواتب التي سبق أن أقرّتها الحكومة على رغم الأزمة الاقتصاديّة في عزّ الموسم الانتخابي، في مفارقة لا تُسجَّل سوى في لبنان. وإذا كان المعنيّون، على غرار رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، وكذلك رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، نفوا بعض ما أشيع، فإنّ أحداً منهم لم ينكر حقيقة "الخطوات الجريئة" المنتظرة، وهنا بيت القصيد.
لكن، وعلى رغم سوداويّة المشهد وصعوبته، فإنّ أحداً لا يعتقد في لبنان بأنّ التظاهرات التي خرجت هذا الأسبوع يمكن أن تتوسّع وترتقي لمستوى "الثورة"، أو أنّ نموذج الربيع العربي، سواء بمعناه الإيجابي أو السلبيّ، قابل للتطبيق في لبنان، ولو كانت كلّ مقوّماته متوافرة، علماً أنّ للبنانيين تجربة سابقة في هذا المجال، من خلال ما سُمي بـ"الحراك المدني"، الذي انطلق على خلفيّة أزمة النفايات التي تحوّلت إلى فضيحة بكل ما للكلمة من معنى.
ولعلّ السبب الجوهري في هذا "التشاؤم" إن صحّ التعبير، لا يتمثل في تجاوز النظام اللبناني الكثير من التحدّيات والاستحقاقات سابقاً، والتي كان يمكن أن تشكّل فرصة لإشعال ثورة حقيقيّة ضدّ الطبقة الحاكمة، ومنها أزمة النفايات على سبيل المثال لا الحصر، ولكن قبل كلّ شيء، بسبب تمتّع هذه المنظومة السياسيّة والطائفيّة بالحصانة المُطلقة، حصانة يتحمّل الشعب مسؤوليّة تكريسها، من خلال تكراره "مبايعة" الوجوه نفسها عند كلّ استحقاق، تارة بذريعة أنّ "هذا الزعيم"، وطوراً لأنّ "لا بديل".
تحالف استراتيجي!
صحيح أنّ "الثورة" ليست كلمة بسيطة، وأنّ شروطاً كثيرة لا بدّ من توافرها قبل قيامها، وإلا تحوّلت إلى "جهنّم" بكل ما للكلمة من معنى، وهو ما حصل أصلاً في أكثر من عاصمة عربيّة، ولا تزال العديد من الشعوب تدفع ثمنه حتى اليوم.
وصحيح أيضاً أنّ الجميع متفقون على أنّ "الثورة" على النظام اللبناني الطائفي باتت ضرورية، بعدما أثبت فشله وعجزه، وباتت الأزمات مرادفاً له في كلّ المحطات، مهما كبرت أو صغرت، حتى أصبح اليوم على حافة الانهيار، بإقرار واعتراف رموزه.
ولكن قبل هذا وذاك، يبقى الأكيد أنّ هذا النظام يحمل بين طيّاته عوامل إخماد أيّ "ثورة" تقوم ضدّه، كيف لا وهو النظام الذي تتباهى مكوّناته المتناقضة في ما بينها حتى العظم، بتحالفٍ استراتيجي مستتر يجمعها، ولو كان على الشعب الذي وُصِف يوماً بالعظيم...