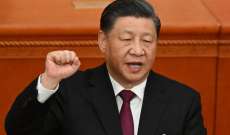من المُفارقة المُضحكة المُبكية، أنّه عندما يتمّ التطاول على الرّئيس، ولا أتحدّث هُنا عن رئيسٍ مُعيّن بل عن الرئاسة بشكلٍ عامّ، تهتزُّ شوارب المؤسّسة كلّها، فيتداعى "الشّرفاء" إلى الدّفاع عن الرئيس، وتعلو الأصوات رفضاً واستهجاناً، كون شرف المؤسّسة من شرفه! ويقف المرؤوس إلى جانب الرئيس. بيدَ أنّه عندما يتمّ التّحامل على المرؤوس، يتنصّل الرئيس من المرؤوس، ولا يعود الشرف شرفاً، ولا المبدأُ مبدأً، ولا المكانةُ مكانَةً، وتبدأ عندها سياسة تدوير الزّوايا، اللّف والدّوران... للأسف، الرئيس نزيهٌ حتّى ولو كان مُذنباً، والمرؤوس مُذنبٌ حتى ولو كان نزيهاً! وهذه هي حالٌ نَحنُ عليها، دينيّاً ومَدَنيّاً.
والصّحيح أنّ الرئيس رئيسٌ بقدرِ ما يخدم الحقّ ويشهد للحقّ ويثبت على الحقَّ ويموت في سبيل الحقّ. الشهادة للحقّ لا تقبل بسياسة تدوير الزّوايا والمواقف الرّمادية. تدوير الزّويا مَقيت لأنّه يُشير إلى أمرٍ ما مُوارِبٍ يُغيّرُ في المواقف فيُزيغها عن الحقّ والعدل، ويُساهِم بإصدار قرارات وأحكامٍ ملتويَة ترمي بثقلِ سوئها على الأبرياء المُحقّين، وذلِك بِما تفترضه المصلحة الشّخصيّة الآنية. والمواقف الرّماديّة ثُنائيّة يمتزج فيها رُكنان لا يلتقيان البتّة، الخير والشرّ، وهي كالقناع الذي يُزيّف الصّورة الأصليّة. ويسوع سأل تلاميذه أن يفكّوا الرّباط مع الأقنعة من خلال معرفة الحق، "تعرِفون الحقّ والحقّ يُحرّركم"(يو8: 32)، فلا يكونوا إزدواجيّين في أقوالِهم وأفعالِم، بل هُم هُم، في الخَفاء وفي العَلَن، كلامهم واحد وأفعالهم واحدة لا زغل فيها ولا غِشّ: "ليَكُن كلامُكم نَعم نعم، ولا لا، وما زاد عن ذلِك كان من الشّرير"(متى5: 37 )، أي كان من الباطل، وما هو باطلٌ هو مُنافٍ للعدل والحقّ.
ويفترض الحقّ من الرئيس أن يكون على جهوزيّةٍ تامّة للتضحية بذاته عن المرؤوس، لا أن يُضَحّي بِه. عندما يُضحّي الرئيس بالمرؤوس خوفاً على "رأسِه" ومكانه ومكانته، وسعياً لإرضاء الناس لا سيّما المُقتدرين في الأرض وأغنياء هذا الدّهر. وعندما يوارب ويُزَوِّر الحقّ بطُرق يظنّها ذكيّة حُبّاً بذاته وبحياته، يموت البريء قتلاً بيد مَن بيده سلطة الغلبة على الباطل، وتَفقد الرئاسة معناها ومُبرّر وجودها، فكيف بنا إذا كان الرئيسُ دينيّاً والمرؤوس دينيّاً أيضاً!.
ويسوع رئيس لأنه شَهِد للحقّ ومات في سبيل الحقّ. أخذَ يسوع صورة عبدٍ، أي خادم، "فوَاضَعَ نَفْسَهُ وَأَطَاعَ حَتَّى الْمَوْتَ مَوْتَ الصَّلِيبِ"...(فيلبي 2 : 7-8)، لكي يحيا بِه كلّ مائتٍ وكلُّ بريء وكُلّ مظلوم ومُضطهد، وكُلّ مُكبَّل ومَطحون، وكُلّ خاطىء. لم يستحقّ يسوع شيئاً من أجل نفسه، بل من أجلنا. مات هو لكي لا نموت نحن، بل لتكون لنا الحياة وافرة(يو10: 10). ويسوع مات لأنّه رئيسٌ حقيقيّ لشعبه(أش9: 6)، ولأنّه راعٍ صالِح لا يُماحِك في محبّته لخرافه ولا في ولائه لها، ولا يهرب عندما تُهاجم الذّئاب الحظيرة وتُحاول افتراس الخراف، بعكس الأجير الذي يُسلّم الخراف إلى الموت حُبّاً بذاته(يو10: 11-16).
في يسوع، يرى كلّ رئيسٍ صورة الرئاسة الحقيقيّة، التي تقوم على العيش في الحقّ والموت في سبيل الدّفاع عن الحقّ ومَن هُم على حقّ. فما هو حقّ هو حقّ، وما هو باطِل هو باطِل. ومَن هو على حقّ هو على حقّ، ومَن هو على ضلال، هو على ضلال. الأمر هو بهذه البساطة ولا يحتمل أيّ تأويل. فلا يظهر الحقّ مُتوّجاً بالباطل، ولا الباطل لابساً جُبّة الصّالحين. والحكمة تقتضي بأنَّ تُسمّى الأشياء بأسمائها، فيكون المُحِقّ مُحقّاً، والمُضِلُّ مُضِلاًّ. هذا ما ينطبق بدوره على العلاقة بين الرئيس والمرؤوس، لا بل بين الناس كلّ الناس، وإلاّ يُصبِح الحقّ والباطل مِثلان، الخروف كالذئب، البارّ كالشرّير، المُستقيم كالمُلتوي، المُحِبّ كالمُبغِض، الآدمي كالأزعر...
ما يليق بِمَن وُضِعت الرئاسة على كتفيه، هو أن يموت من أجل مرؤوسيه حتى ولو كانوا غير مُستحقّين. وما لا يليق به هو أن يُميت مرؤوسيه من أجل نفسه. هُنا، وهنا بالذّات، تكمن كلّ الحكمة وكلّ الشّرف وكلّ الحُبّ.