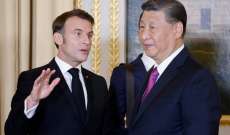قد تكون المرّة الأولى في لبنان منذ سنواتٍ طويلة، التي تعود فيها "الحيويّة" و"الديناميكيّة" إلى مصطلح "المعارضة" الذي كاد اللبنانيون ينسونه على امتداد الحكومات المتعاقبة، خصوصاً بعد العام 2005، والتي كرّست عرفاً سُمّي بـ"الوحدة الوطنية" تارةً، و"الوفاق الوطني" طوراً، واختزلت المبدأ الأول والأساس لأيّ مسار ديمقراطيّ جدّي.
فباستثناء تجربة حكومة نجيب ميقاتي الشهيرة، التي اصطلح على تسميتها في بعض الأوساط بحكومة "حزب الله"، والتي وجدت من يعارضها بشراسة، لم تظهر المعارضة خلال الأعوام الأخيرة، إلا عبر تجارب يتيمة وخجولة نسبياً، غلبت عليها "الشعبويّة"، وافتقدت عوامل القوّة، ما جعل أصحابها عُرضةً للنقد وحتى المساءلة.
اليوم، تبدو الصورة مختلفة على وقع الاستشارات التي يجريها رئيس الحكومة المكلَّف حسّان دياب لإنجاز مهمّته، بل إنّ "جبهة" المعارضة استهلّت عملها باكراً، من دون انتظار كشف النقاب عن التشكيلة الحكوميّة المرتقبة، "جبهة" يبدو من معالمها الأولية أنّها تضمّ كلّ الأطياف، من أحزاب "المستقبل" و"القوات" و"الاشتراكي" و"الكتائب"، وصولاً إلى المجتمع المدني ومن يدور في فلكه.
فهل يكون اللبنانيون على موعدٍ مع معارضةٍ فعّالةٍ، منتجة وموحّدة تعيد الاعتبار للعمل الديمقراطيّ الحقيقيّ، وتطيح بكلّ "البِدَع" التي سيطرت على المشهد أخيراً، أم أنّ ما يحصل لن يكون سوى حلقة من مسلسلٍ سئمه اللبنانيون لكثرة تكراره؟!.
إنجازٌ... ولكن!
لا شكّ بدايةً، وبمُعزَلٍ عن كلّ الحيثيات والخلفيّات المحيطة بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، والتي بدأت مع تكليف حسّان دياب من أحزابٍ تعبّر عن طيفٍ سياسيّ معيّن، أنّ إعادة الاعتبار لمبدأ "المعارضة" في العمل السياسيّ، تشكّل "إنجازاً" طال انتظاره، في بلدٍ يدّعي القيّمون عليه أنّه ديمقراطيّ، ويشكو المواطنون فيه من غياب الحدّ الأدنى من مظاهر "الديمقراطية" الحقيقيّة فيه.
من هنا، قد يكون النقاش الذي ساد الأوساط السياسيّة أخيراً، على رغم "الهلع" الذي أنتجه في بعض الأوساط الشعبية من الذهاب نحو "الانهيار" وما شابه، إيجابياً، أقلّه من حيث "حماسة" العديد من القوى السياسية إلى التموضع في صفوف المعارضة، ولو برّر كثيرون الأمر تارةً بأنّه يندرج في خانة "تحسين الشروط التفاوضية" ليس إلا، بالنظر إلى الخلافات "التكتيكية" بين الأفرقاء، وتارةً أخرى بأنه يصبّ في إطار "الهروب من المسؤوليّة"، على اعتبار أنّ أحداً لا يرغب بأن يسجّل التاريخ عليه مشاركته في حكومة "انهيار".
ولعلّ "الإيجابية" هنا ترتكز إلى الإطاحة بما سُمّيت "تسويات" كانت دائماً تتمّ وفق قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"، وكأنّ احترام مبادئ الديمقراطية التي تقوم على وجود أغلبية تحكم وأقلية تعارض هو "إعلان حرب" مثلاً، "إيجابيّة" تكتسب أهمية مضاعفة بالنظر إلى "الحيثيّة" التي تتمتّع بها الأحزاب الخارجة من الحكم، إرادياً أو قسرياً، وحضورها بشكلٍ خاص في الندوة البرلمانية، حيث يفترض أن يكون لديها القدرة على تحقيق الكثير، تطبيقاً لمقولة "المراقبة والمحاسبة" التي تتمتّع بها السلطة التشريعية، من دون أن تمارسها في حكوماتٍ كانت "نسخة مصغّرة" عن البرلمان.
فإذا كان حزب "الكتائب" مثلاً، من بين قلّة خرجوا عن هذه القاعدة في السنوات الأخيرة، فإنّ معارضته بقيت "صُوَريّة" تغلب عليها "الشعبويّة" برأي كثيرين، شأنها شأن بعض المستقلّين الذين لا يتخطى عددهم أصابع اليد الواحدة، وهو ما كان يقرّ به المعارضون أنفسهم، باعتبار أنّ "يداً واحدة" لا تستطيع التصفيق، إذ إنّ أقصى ما كانوا يستطيعون فعله هو رفع الصوت كلما سنحت الفرصة لهم، من دون القدرة على سحب ثقةٍ، أو فرض استجواب وزير أو مساءلة آخر.
معارضات متشتّتة؟!
يبدو الواقع مختلفاً اليوم، إذ لم يعد حزب "الكتائب" وحده في المعارضة، إلى جانب المستقلّين محدودي العدد، بل انضمّت إليهم شرائح واسعة تشكّل أكثر من ثلث البرلمان، ويمكن أن تصل إلى النصف، بل أن تتخطّاه إذا ما استطاعت "اجتذاب" بعض القوى المصنّفة ضمن الموالاة، والتي تغرّد في سربها الخاص في الكثير من الأحيان.
بيد أنّ المشكلة الحقيقيّة التي تواجه هذه المعارضة، أو بالأحرى "المعارضات"، تتمثّل في تشتّتها الواضح، وعدم القدرة على أن تجتمع في إطارٍ واحد، ولو وفق مبدأ "وحدة الهدف"، أي معارضة الحكومة وصولاً إلى إسقاطها، خصوصاً أنّ ما بين بعض هذه المعارضات من تشابكٍ في العلاقات، يكاد في بعض الجوانب يتفوّق على ذلك الذي يطبع علاقتها مع قوى السلطة الحاكمة اليوم.
فعلى سبيل المثال، لا يمكن أن يكون "تيار المستقبل" الذي يسعى اليوم لقيادة المعارضة، في "تناغمٍ" مع أيّ من أطياف المعارضة الأخرى، والتي ارتبط بمعظمها بتحالفاتٍ سابقة، ليس فقط لأنّ هذه القوى تحمّله أساساً المسؤولية الكبرى في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، بعد تخلّيه عن حلفائه بموجب "التسوية الرئاسية"، ولكن قبل ذلك لأنّ معارضة "المستقبل" تبدو قائمة على فكرة "الإطاحة" برئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، علماً أنّ "شركاءه" في المعارضة شاركوا في هذه "الإطاحة"، بل ثمّة من يحمّل "القوات اللبنانية" المسؤولية الأكبر على هذا المستوى.
ولا يبدو واقع "القوات اللبنانية" أفضل، هي التي تبدو علاقتها مع "المستقبل" في أسوأ حالاتها، ولو أصرّت على قول العكس، فيما مرّت علاقتها بحزب "الكتائب" مثلاً بما هو أسوأ، خصوصاً خلال مرحلة الحكومة الأخيرة، حيث وصل التراشق بين الجانبين إلى حدّ التخوين الذي دخلت قيادات الحزبين على خطّه مباشرةً، بدل وضع حدّ له. أما "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي لا يزال كثيرون يراهنون على أنه لن "يصمد" في المعارضة، ولن يتردّد في "الانعطاف" إذا ما شعر أنّ لحكومة دياب حظوظاً جدية في الحكم، فتبدو تغريدات رئيسه وليد جنبلاط كافية لإدراك "الهوة" القائمة بينه وبين كلّ أطياف "المعارضة" الباقية، والتي مرّت علاقته بها بالكثير من الهبّات الساخنة والباردة أخيراً.
أين المعارضة الحقيقية؟
في الظاهر، قد يكون تعدّد أطياف المعارضة وتنوّعها أمراً إيجابياً ودافعاً إلى التفاؤل بالعودة إلى الجذور، وتحديداً إلى قاعدة "الموالاة والمعارضة"، التي يفترض أن تكون بديهيّة في أيّ نظامٍ يدّعي "الديمقراطية".
ولكن، هل هذه هي المعارضة التي يسعى إليها اللبنانيون؟ أليست هذه المعارضة من رحم السلطة والموالاة؟ أليست هذه المعارضة هي التي أسّست، إلى جانب قوى السلطة الحالية، للنظام الاقتصادي والمالي والسياسي الحاكم بقوة الأمر الواقع؟.
ثمّ، والأهمّ، هل كانت هذه المعارضة لتتحمّس للانتقال من خندق السلطة، في ظروفٍ مختلفة، وتحديداً قبل "الثورة"؟ أليس بين هذه المعارضات من التحق بالمعارضة أخيراً، فقط لأنّ شروطه لم تتوافر، أو لأنّ هناك من رفض تكريسه في منصبٍ معيَّن؟!.
صحيحٌ أنّ العبرة تبقى في الخواتيم، لكنّ اللبنانيين بحاجة إلى معارضة حقيقية وجدية، معارضة لا تكون "ردة فعل"، بل تكون هدفاً بذاتها، معارضة قد لا تكون مقوّماتها متوافرة حالياً، أقلّه في البرلمان الحالي الناتج عن "تسويات" المتخاصمين اليوم!.