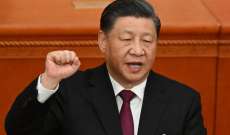كلامُ الربِّ يسوعَ المسيحِ عن الأغنياءِ والفقراءِ عميقٌ جدًّا ودقيق. إذا قلنا مثلًا إنّ كلَّ غنيّ مرفوض، وكلَّ فقيرٍ ضامنٌ دخولَه ملكوتَ السّماوات، لَوقعنا في شططٍ كبير، وأَضعنا المعنى الحقيقيّ، لأنَّ الغنيَّ الذي قصدَهُ يسوعُ هو مَن استغنى عن الإلهيّاتِ بالماديّات، واعتبر أنَّ غناهُ التُّرابيَّ مِن مالٍ ومُمتلكاتٍ ومَزايا هو كلُّ شيء، ولا حاجة له لله، وبات يعتبر نفسه إلهًا ويعبُدُ ذاتَه.
والفقيرُ هو مَن يَفتقِرُ إلى اللهِ ليُغنيَهُ، إن كان معدومَ المالِ أو دُونَ الوَسطِ أو متوسِّطَ الحال، أو حتّى ثريًّا.
وبهذا يمكن أن نَجدَ فقراءَ أغنياءَ وأغنياءَ فقراء.

ويأتي ما يقوله الربّ في سفر الرؤيا واضحًا عن موضوع الاستغناء: "لأَنَّكَ تَقُولُ: إِنِّي أَنَا غَنِيٌّ وَقَدِ اسْتَغْنَيْتُ، وَلاَ حَاجَةَ لِي إِلَى شَيْءٍ، وَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ أَنْتَ الشَّقِيُّ وَالْبَائِسُ وَفَقِيرٌ وَأَعْمَى وَعُرْيَانٌ. أُشِيرُ عَلَيْكَ أَنْ تَشْتَرِيَ مِنِّي ذَهَبًا مُصَفًّى بِالنَّارِ لِكَيْ تَسْتَغْنِيَ، وَثِيَابًا بِيضًا لِكَيْ تَلْبَسَ، فَلاَ يَظْهَرُ خِزْيُ عُرْيَتِكَ. وَكَحِّلْ عَيْنَيْكَ بِكُحْلٍ لِكَيْ تُبْصِرَ"(رؤيا ١٧:٣-١٨).
تُرى ما هو "الذَّهبُ المُصَفًّى بِالنَّارِ" وكيف نشتريه؟.
لقد سبق هذه الآيات آيتان تضعان النُّقاطَ على الحروف، وتحدِّدان محورنا الإيماني، وتساعداننا للوصول إلى المعنى، إذ يقول الربّ: "أَنَا عَارِفٌ أَعْمَالَكَ، أَنَّكَ لَسْتَ بَارِدًا وَلاَ حَارًّا. لَيْتَكَ كُنْتَ بَارِدًا أَوْ حَارًّا! هكَذَا لأَنَّكَ فَاتِرٌ، وَلَسْتَ بَارِدًا وَلاَ حَارًّا، أَنَا مُزْمِعٌ أَنْ أَتَقَيَّأَكَ مِنْ فَمِي"(رؤيا ١٥-١٦).
الفتور نتيجةُ عدمِ الحِسِّ وهو السُّكون السَّلبيُّ وعدمُ التَّفاعلِ ويُؤدّي إلى الازدراء. هذه بالضَّبط خطيئةُ الغَنيِّ تجاه لعازرَ في المَثلِ الذي يُوردُه لوقا الإنجيلي.
لم يكن الغنيُّ يتفاعل مع ألمِ لعازر، ولم يكن يشعرُ به كإنسانٍ مَع أنّه كان مَرميًّا أمام بابِ منزلِه. لقد فتُرتِ الإنسانيّةُ عند الغنيّ، وبالتّالي فَقَدَ حِسَّ الوجود. يقول القدّيس اسحق السرياني: أعظمُ الخطايا فُقدانُ الحِس. وهو فقدانٌ ثُلاثيٌّ: تجاه الخالق، وتجاه الآخر وتجاه الذّات، إذ يدخُل الإنسانُ في نَفقِ الموتِ والظَّلامِ حتّى وإن كان يظُنُّ العكس.
والسبيل الوحيد للخروج مِن هذا النفق المميت هو التحرّر مِن كلّ ما يجعل الإنسان عبدًا لإبليس وعابدًا لنفسه. أي أن يَصفوَ مِن الداخل، وهذا الصفاء لا يتم إلّا بتفعيّل النِّعمةِ المجانيّةِ المُعطاةِ لنا مِن الربّ مباشرة. "مُتَبَرِّرِينَ مَجَّانًا بِنِعْمَتِهِ بِالْفِدَاءِ الَّذِي بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ"(رومية ٢٤:٣).
صحيح أن الربّ يقول لنا أن نشتري منه، ولكن في الحقيقة هو ليس شراء بقدر ما هو قبولٌ لخلاص إلهنا لنا، الذي افتدانا بدمه واشترانا له احرارًا، وهو يدعونا في كلّ لحظة في حياتنا قائلًا: "أَيُّهَا الْعِطَاشُ جَمِيعًا هَلُمُّوا إِلَى الْمِيَاهِ، وَالَّذِي لَيْسَ لَهُ فِضَّةٌ تَعَالَوْا اشْتَرُوا وَكُلُوا. هَلُمُّوا اشْتَرُوا بِلاَ فِضَّةٍ وَبِلاَ ثَمَنٍ خَمْرًا وَلَبَنًا"(إشعياء ١:٥٥).
الربّ غِنانا، إذ هو افتقر مِن أجلنا لِكَيْ نستغني به (٢ كورنثوس ٩:٨)، فها نحن نستبدل الذهب بالقش، نترك مجدَ الله ونتبع مجدًا ترابيًّا، فندمّرُ ذواتِنا والعالمَ مِن حولِنا بما فيهِ مِن بشرٍ وكائناتٍ وطَبيعة، إلى حدِّ تُصبِحُ فيه بعض الحيوانات كالكلاب مثلاً تَفوقُ الإنسانَ بالرحمة والرأفة والمعاملة والمحبّة والوفاء والإخلاص. وهذا الأحد تُخبرنا الكنيسةُ كيف كانتِ الكلابُ تأتي وتلحسُ قُروحَ لَعازر.
كان الغنيُّ في الظاهر يلبس الأرجوان ولكن في الحقيقة كان عريانًا إلّا مِن الأنانيةِ وعبادةِ الذات وفُقدانِ القَلب، فبات هيكلًا مِن لحمٍ وعظمٍ لا حياةَ فيه. لا بل، ظهرتْ عُريتُه أمام الإنسانِ الآخرِ، وهنا بيت القصيد.

أستذكر هنا ما وصفه الأديب الفرنسي Gustave Flaubert في روايته L’Education Sentimentale عن عديدٍ مِن الاحتفالات المليئة مِن الأطباق والأجراس وأدوات المائدة وملاعق مِن الفضة والقرمز، وملذّات الطعام ولوحات تصويريّة بين الطعام والدين والفن، وكلّها مبنيّة على تمجيد الذات وعرض القوّة والسلطة وسحق الآخرين.
بالعودة إلى الإصحاح الثالث في سفر الرؤيا يكمل الربّ: "ها أنَذَا وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ الْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي" (رويا ٢٠:٣). لعازرُ يُمثّل المسيحَ، وكان واقفًا على باب ذلك الغنيّ الّذي منعَتهُ قساوةُ قلبه مِن رُؤيةِ الرَّبِّ وسماعِ صوتِه، فلم يفتحِ البابَ لَه ولم يَدخلِ الربُّ منزِلَه، ولم يجلسْ إلى مائدتِه. فبقيتْ مائدتُهُ بلا طعم أو مذاق، فقط صحون بالية لا قيمة لها.
التحدّي الكبير في هذه الأيام وفي كلِّ عصر، أن نلبسَ المسيحَ ونفتحَ له أبوابَ قُلوبِنا وبيوتِنا وعائلاتنا ومراكزِ عملِنا وأوطانَنا ليدخُلَها الربُّ، ويدفئَها ويتعشّى معنا، أي يُطعمنا من خبزِه الجوهريّ الأبدي الذي يعطينا الحياة الأبديّة، فلا نعود عديمي الحس لا نسمع صوت الله ولا نراه في الآخرين.
في سحر الفصح يطرق الكاهن باب الكنيسة قائلًا "ارفعوا أيُّها الرؤساء أبوابكم، وارتفعي أيتها الأبواب الدَّهريَّة، فيدخلَ ملك المجد"! وهذه الصَّرخة هي مِن المزمور الرابع والعشرين.
ألم يحن الوقت ليرفع رؤساء هذا العالم والدول والوطن والحكّام وأرباب العمل وأربابُ البيوت والعائلات وكلُّ فرد منّا أبوابَ قلبه الحجريّة فيدخل الربّ إلينا ولا نبقى مَرميّين ننتظرُ مَن يَلحسُ قروحَ نُفوسِنا المليئةِ بِالبُغضِ والأَنانية؟.
ينتهي مَثَلُ لَعازرَ والغنيّ بهُوّةٍ كبيرةٍ بين السَّماءِ وجَهَنَّم، ولكنَّ المهمَّ فيهِ هُوَ نَحن، كيف نرسم مَصيرَنا بِيَدِنا، ونقرِّرُ أين سنكون لاحقًا. ألا اتّعظنا قبل فوات الأوان؟.