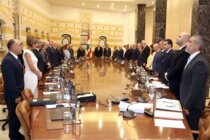لم يعد من الممكن الحديث اليوم عن أزمة عابرة في العلاقات السعودية الأميركية، التي قامت منذ سنوات طويلة على معادلة النفط مقابل الأمن، فالمسؤولون في البلدين باتوا يتحدثون صراحة عن إنتهاء عصر "الأيام الخوالي"، بالرغم من حرص الرئيس الأميركي باراك أوباما على زيارة الرياض قبل نهاية ولايته الثانية.
في الأيام الأخيرة، عكست المواقف والتحليلات، التي ظهرت في وسائل إعلام البلدين، حجم الهوة في العلاقة بين بلاد "العم سام" والمملكة، في مؤشر إلى أنها دخلت مرحلة جديدة لا يمكن معها العودة إلى الوراء، في ظل الحديث عن إحباط متبادل نتيجة الفشل في معالجة الملفات التي تهم الجانبين، بالرغم من التاريخ الكبير في تبادل الخدمات المشتركة.
في هذا السياق، لم يكن من الممكن أن ينجح مؤسسو السعودية في بناء مملكتهم لولا الدعم الأميركي لهم، بدءاً من مساعدتهم على هزيمة منافسيهم من الهاشميين في بداية القرن الماضي، من دون إهمال المرحلة التي كانت الرياض تخوض فيها معارك شرسة مع الحركات الوطنية والقومية قبل عشرات السنوات، أي أيام بروز الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وصولاً إلى حمايتها من الإتهامات بالوقوف وراء هجمات الحادي عشر من أيلول الإرهابية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ثم تحصينها من "عدوى" ما يسمى "الربيع العربي".
في المقابل، لم تكن واشنطن قادرة على الوقوف بوجه المدّ الشيوعي في الشرق الأوسط، أيام الحرب الباردة مع الإتحاد السوفياتي، من دون مساعدة المملكة، التي أمّنت لها كل مقومات النجاح في هذه المواجهة، وهو ما ظهر جلياً في حرب أفغانستان، حيث لعبت السعودية دوراً بارزاً في تجنيد "المجاهدين" وتقديم مختلف أنواع الدعم لهم، قبل أن تعود الولايات المتحدة إلى تصنيفهم "إرهابيين" بسبب إختلاف المصالح ووجهات النظر، بالإضافة إلى دورها في المواجهة مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي حرف بوصلة الصراع عن إسرائيل، التي كانت ولا تزال ركناً أساسياً في الإستراتيجية الأميركية في المنطقة، لكن ما الذي ساهم في تبديل المشهد السابق على نحو دراماتيكي؟
التحالف التاريخي بين الولايات المتحدة والسعودية لم يهتز نتيجة إنقلاب في الحكم بأي منهما، أو تبدل على مستوى الأسس التي يقوم عليها النظام فيهما، لكن لعبة المصالح تبدلت، فواشنطن لم تعد بحاجة إلى نفط الرياض بالشكل الذي كانت عليه في السابق، نتيجة الإنتاج الأميركي من الوقود، وتكنولوجيا الوقود الصخري، في وقت حافظت السعودية على كثافة إنتاجها من النفط للحفاظ على انخفاض أسعاره، فأصبح الإنتاج غير اقتصادي بالنسبة إلى الأميركيين، مع الأخذ بعين الإعتبار تداعيات زيادة الإنتاج الإيراني على مستوى الأسعار.
 هذا التحول على مستوى المصالح الأميركية، يأتي في مرحلة تبدو الرياض بأمس الحاجة فيها إلى الحماية، لا سيما مع عودة طهران إلى الساحة الدولية بعد توقيع الإتفاق النووي معها، التي جاءت مع إنفجار الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، من ليبيا إلى مصر وصولاً إلى سوريا والعراق، لا بل لم تبقَ بعيدة عن البلدان الخليجية نفسها حيث الأوضاع المضطربة في البحرين والمناطق الشرقية من السعودية، من دون إهمال صعود نجم الجماعات المتطرفة، التي تقدم نفسها دائماً بصورة البديلة عن الأنظمة التي فشلت في تأمين مصالح وأمن شعوبها، لا بل هي متهمة بسرقة الموارد الطبيعية والتآمر على القضايا الوطنية.
هذا التحول على مستوى المصالح الأميركية، يأتي في مرحلة تبدو الرياض بأمس الحاجة فيها إلى الحماية، لا سيما مع عودة طهران إلى الساحة الدولية بعد توقيع الإتفاق النووي معها، التي جاءت مع إنفجار الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، من ليبيا إلى مصر وصولاً إلى سوريا والعراق، لا بل لم تبقَ بعيدة عن البلدان الخليجية نفسها حيث الأوضاع المضطربة في البحرين والمناطق الشرقية من السعودية، من دون إهمال صعود نجم الجماعات المتطرفة، التي تقدم نفسها دائماً بصورة البديلة عن الأنظمة التي فشلت في تأمين مصالح وأمن شعوبها، لا بل هي متهمة بسرقة الموارد الطبيعية والتآمر على القضايا الوطنية.
لدى بعض الأوساط السعودية قناعة تامة بأن واشنطن تخلت عن المملكة، بسبب مصالحها التي تتطلب التفاهم مع كل من روسيا وإيران، في حين لا تملك الرياض القدرة على التراجع إلى الوراء، بعد أن رفعت سقف مطالبها عالياً، وليس لديها الكثير من الحلول التي تمنع التدهور المستمر في الأوضاع، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، لكن الأكيد أن عليها التأقلم مع فكرة أن الولايات المتحدة لن تخوض أي مواجهة عسكرية للدفاع عنها، خصوصاً أن الرأي العام الأميركي لا ينظر بعين الرضا إلى الأدوار السعودية على مستوى العالم، فالمعادلة واضحة: "أميركا الدولة العظمى لا تعمل حسب الإملاءات السعودية، بل تسعى إلى تأمين مصالحها بالطريقة التي تراها مناسبة".
في الأشهر الأخيرة، كانت كل المعلومات تتحدث عن رهان سعودي على تحوّل منتظر في مواقف البيت الأبيض بعد الإنتخابات الرئاسية المقبلة، لكن المعطيات الحالية لا تُبشر بالخير، نظراً إلى أن الرئيس المقبل لن يكون قادراً على إحداث تحول جذري مهما كانت سياساته، الأمر الذي دفع المملكة ربما إلى البحث عن بدائل أخرى، على شكل تدعيم التحالف مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أو بناء تحالف إستراتيجي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بغرض فرض توازن قوى بوجه القوى الأخرى، إلا أن الخلافات بين الثلاثي المذكور تمنع الرهان على نجاحه.
ما تقدم لا يعني أن الولايات المتحدة تخلت كلياً عن الدول الخليجية، خصوصاً السعودية، لكنها في المقابل لن تقدم على أي خطوة كرمى لعيونها إلا إذا كانت مصالحها تستدعي هذا الأمر، فأوباما أكد، عقب إنتهاء أعمال القمّة الخليجية الأميركية، على إستمرار التعاون بين الجانبين، لكنه حدد إطاراً له عبر مكافحة الإرهاب، وهو على الرغم من إشارته إلى سوريا وإيران لن يقدم على أي خطوة باتجاههما.
في المحصلة، العهد الأميركي الحالي أنهى إلى حد بعيد معادلة الأمن مقابل النفط، بسبب إنتفاء حاجته منه، حيث الأنظار تتجه إلى حقول الغاز الضخمة في مناطق أخرى من العالم، إلا أنه فتح أبواب مصانعه الحربية أمام الدول الخليجية، التي باتت لا تتردد بالدخول في الحروب، كما هو الحال في اليمن.