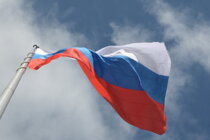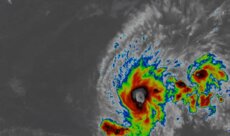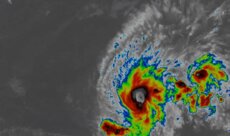لا تزال "الضبابية" تحيط بالمشهد الانتخابي اللبناني قبل ثلاثة أشهر فقط من موعد الاستحقاق المفترض في 15 أيار المقبل، حيث تحافظ معظم القوى السياسية على "تريثها" في حسم تحالفاتها وبلورة شعاراتها، وكأنّ هناك من ينتظر "أمرًا ما" قد يطرأ في اللحظات الأخيرة، يعيد النظر بمسار الانتخابات عن بكرة أبيها.
لكن، رغم طغيان "الارتباك" على المشهد، بدأ العمل "الجدّي" في الكواليس تحضيرًا للانتخابات، في ضوء "الضغط" اللافت الذي يمارسه المجتمع الدولي لإنجاز الاستحقاق ورفض أيّ "مراوغة" على خطّه، في ظلّ "رهان" لا يبدو مخفيًا من جانب العديد من الدول الغربية على تغيير "جذري" ستفضي إليه هذه الانتخابات.
إلا أنّ هذا "الغموض" يسري على ما يبدو على المجتمع المدني أيضًا، أو ما تُعرَف بـ"قوى التغيير"، والتي لا يبدو أنّها في "أتمّ الجهوزية" للاستحقاق، رغم كثرة "الرهانات" عليها، حتى إنّ هناك من يجزم سلفًا أنّ المؤشرات الحالية توحي أنّ سيناريو 2018 سيعيد نفسه في انتخابات 2022، على صعيد الترشيحات أولاً والنتائج في نهاية المطاف.
فما صحّة مثل هذا الاعتقاد، وما هي مبرّراته؟ وكيف تستعدّ القوى المدنية للاستحقاق الموعود؟ هل تكرّر "خطيئة" 2018 فتخوض المعركة متخاصمة ومشتّتة، تحت عنوان "الغنى" الموهوم، أم تقفز فوق اختلافاتها وانقساماتها، فتتّحِد في لوائح واحدة، لعلّها تنجح بذلك في "انتزاع" بعض المقاعد من الأحزاب والقوى التقليدية؟!.
قد لا يكون خافيًا على أحد أن المهمّة الملقاة على عبء قوى "التغيير" هذه كبيرة، وربما تفوق قدرتها وطاقتها، خصوصًا أنّ هناك من يعتقد أنّ الكرة باتت في ملعبها فعلاً، بالنظر إلى التدهور غير المسبوق في "شعبيّة" قوى السلطة، على وقع الأزمات المتلاحقة التي شهدتها البلاد على مدى العامين الماضيين، ولا سيما الأزمة المالية والاقتصادية، والتي أدّت إلى "نفور" الكثير من المؤيدين، وحتى المحازبين، وابتعادهم عن القيادة الحزبيّة إلى حدّ بعيد.
ولعلّ "تعقيدات" هذه المهمّة تتعزّز أكثر بالنظر إلى "حساسيّة" هذه الانتخابات، التي تُعَدّ "تحديًا حقيقيًا" لقوى "التغيير"، كونها الأولى التي تتمّ منذ حراك 17 تشرين الذي، وبمُعزَلٍ عن النتائج التي تمخّض عنها على أرض الواقع، أحدث "انقلابًا" في الموازين، على الأقلّ من حيث كسر الكثير من الصور "النمطيّة"، وإزالة "الجليد" المتراكم على فكرة "التغيير والثورة"، وما يمتّ إليها بصلة.
وليس سرًا أيضًا أنّ هذه القوى تحظى بدعم "عابر للحدود"، إن جاز التعبير، حيث إنّ الكثير من القوى الغربية التي تتمسّك بموعد الانتخابات، تراهن على المجتمع المدني تحديدًا لإحداث "الفارق المرجو"، وهي بهذا المعنى "تمنّي النفس" بانقلاب "سلميّ" عبر صناديق الاقتراع، إن جاز التعبير، على الطبقة السياسية التقليدية، خصوصًا أنّ المقوّمات المتوافرة لمثل هذا "الانقلاب" اليوم قد لا تتكرّر، بالزخم نفسه على الأقلّ، في المستقبل القريب أو البعيد.
إلا أنّ كلّ ما سبق على أهميته وحساسيّته في وادٍ، ووضع القوى المدنية يبدو في وادٍ آخر تمامًا، وفق كل المؤشرات والمعطيات المتوافرة. فعلى الرغم من كلّ الرهانات المعقودة على المجتمع المدني، وبغضّ النظر عن المنتديات والملتقيات والحوارات التي يتمّ تنظيمها، لا يبدو أنّ قوى "التغيير" قد وصلت فعليًا إلى نقطة "الالتقاء والتقاطع"، وبالتالي "التحالف"، بما يمهّد لخوض الانتخابات المقبلة على لوائح "موحّدة" فعلاً.
ويقول العارِفون إنّ هذه القوى لا تزال "منقسمة" على طريقة مقاربة الاستحقاق الانتخابي المقبل، حيث لا يزال فريق واسع منها متمسّكًا بمقولة "كلن يعني كلن"، ويرفض انطلاقًا من ذلك، "مدّ يده" إلى أيّ من الأحزاب والقوى التي تناوبت على السلطة على مدى العقود الأخيرة، بما فيها تلك التي "تسلّقت على الثورة"، إن جاز التعبير، أو تلك التي اختارت الانتقال إلى "المعارضة" تزامنًا مع انفجار الحراك الشعبيّ.
في المقابل، ثمّة فريق لا بأس به ضمن المجتمع المدني، لا يمكن القفز فوقه، يدعو إلى مقاربة أكثر براغماتية، تقوم على وجوب التعامل مع الواقع القائم بـ"واقعية"، ولو تطلّب ذلك التحالف، أو بالحدّ الأدنى، التنسيق مع بعض القوى السياسية، ولا سيما المناطقية منها، بما يرفع من "حظوظ" الخرق الفعليّ لمجموعات السلطة الحاليّة، بدل تشتّت الأصوات بين المجتمع المدني والمعارضة، ما قد يشكّل "هدية مجانية" للأحزاب التقليدية.
ولا شكّ أنّ طبيعة القانون الانتخابي المعقّد، والمفصّل وفق ما يؤكد الكثير من الخبراء القانونيين والانتخابيّين، على قياس الطبقة السياسية، يزيد هذا "الاختلاف"، حيث يرى كثيرون أنّه لا بدّ للمجتمع المدني أن "يحارب" بسلاح الطبقة السياسيّة نفسها، ولا سيما لجهة ضرورة الانخراط في لوائح، ووجوب حصول الأخيرة على حاصل انتخابي، يتفاوت حجمه بين دائرة وأخرى، في مقابل "فيتو" يضعه آخرون على أيّ "براغماتية" من هذا النوع.
في النتيجة، الواضح حتى الآن بنتيجة هذه التباينات والاختلافات، أنّ قوى المجتمع المدني تخوض الاستحقاق الموعود، أقلّه حتى الآن، وهي مشتّتة متفرّقة، ما يدفع إلى الاعتقاد بأنّ سيناريو 2018 سيتكرّر بصورة أو بأخرى، بمعنى أنّ هذه القوى بدل أن تتّحد في لوائح واحدة، ستتفرّق على لوائح متنوّعة ومختلفة، فتتشتّت معها الأصوات، ويضيع الناخبون بين برامج وشعارات تشبه بعضها في المضمون.
ولعلّ حالة "القرف" التي تعبّر عنها استطلاعات الرأي خير دليل على أنّ النتيجة قد لا تكون "مغايرة" أيضًا، حيث إنّ الكثير من اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية يبدون "ميّالين" إلى مقاطعة الانتخابات بالمُطلَق، لأنّهم لا يجدون في القوى المدنية، المشترذمة والمشتّتة، "البديل" الذي يتوقون إليه، "بديل" قد لا يكون الوقت قد فات على القوى المدنية للعمل على تكريسه، إلا إذا أرادت أن يعيد التاريخ نفسه، وتقتصر "انتصاراتها" على مقاعد لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة!.