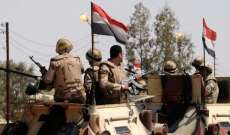حتى اليوم، لا تزال العديد من ملابسات الإنقلاب العسكري الفاشل الذي حصل في تركيا غامضة. البعض يعتبر أن الدول الغربية وقفت خلفه بهدف التخلص من الرئيس رجب طيب أردوغان، في حين أن هناك من يؤكد أن "السلطان" قام بهذه الخطوة بهدف التخلص من "أعدائه"، لا سيما أن بلاده كانت تمر بأزمات داخلية وخارجية لا حلول لها في الأفق.
بعيداً عن كل هذه السيناريوهات، من الضروري متابعة الواقع في أنقرة، في المرحلة الراهنة، حيث نجح زعيم حزب "العدالة والتنمية" في تحويل الخطر إلى فرصة ذهبية على كافة المستويات، لا بل حوّله إلى صالحه بطريقة مدهشة، بعد أن ظنّ الكثيرون أن تركيا ما بعد الإنقلاب لن تكون كما كانت قبله، بسبب إنشغالها بأزماتها الخاصة.
في هذا السياق، عَمَدَ أردوغان سريعاً بعد إحباط العملية الإنقلابية إلى ترسيخ دعائم سيطرته على كافة مؤسسات الدولة، عبر عملية "تطهير" فاقت كل التوقعات من خلال الأعداد التي وصلت لها، خصوصاً بعد أن حصل على دعم من مختلف القوى السياسية في البلاد، لكن الهدف الأساسي بالنسبة له كان المؤسسة العسكرية، حيث كان بين ضباطها من يعارض توجهاته.
بالإضافة إلى ذلك، تمكن "السلطان"، في الداخل التركي، من إسكات كافة الأصوات المعارضة له، حيث تحول إلى القائد السياسي الذي من المفترض الدفاع عنه، كونه يمثل القيم "الديمقراطية" و"الشرعية" في مواجهة محاولات إعادة البلاد إلى الوراء، التي تقف خلفها "أيادٍ خارجية"، بعد أن كانت المعطيات توحي بفقدانه القدرة على تأمين التعديل الدستوري الذي ينقل أنقرة إلى النظام الرئاسي، الذي يحلم به منذ سنوات، لكن النجاح الأكبر يبقى في موقع تركيا الخارجي، سواء كان ذلك إقليمياً أم دولياً.
على المستوى الإقليمي، نجح أردوغان في تسويق نفسه بوصفه زعيماً إسلامياً، تراهن فئات واسعة على دورِه في حمايتها، وهو يسعى إلى تأكيد هذا الأمر من خلال الإنتقال إلى تنفيذ عمليات خارجية، كتلك التي تحصل في الشمال السوري تحت عنوان محاربة الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تكريسه دوره في أي حلّ للأزمة القائمة منذ سنوات، فهو بات حاجة روسيّة وأميركيّة معاً، و"السلطان" يبرع في اللعب على التناقضات للإستفادة منها إلى أقصى حد ممكن.
 في هذا السياق، لم يكن من الممكن، قبل الإنقلاب العكسري الفاشل، أن تذهب تركيا إلى تدخّل مباشر في الحرب السوريّة يؤمّن حصولها على المنطقة الآمنة التي كانت تحلم بها، بسبب الخطوط الحمراء التي كانت موضوعة من قبل موسكو وواشنطن، لكن اليوم تدخلها يحظى بمباركة الطرفين معاً، فالأولى تعتبر أن دورها لا يمكن تجاوزه في محاربة الإرهاب، في حين أنّ الثانية تغطّيه عبر طائرات التحالف الدولي الذي تقوده، لا بل حتى لا يحظى بمعارضة شرسة من قبل كل من طهران ودمشق، بسبب المصلحة المشتركة في منع نشوء كيان كرديّ جديد في المنطقة.
في هذا السياق، لم يكن من الممكن، قبل الإنقلاب العكسري الفاشل، أن تذهب تركيا إلى تدخّل مباشر في الحرب السوريّة يؤمّن حصولها على المنطقة الآمنة التي كانت تحلم بها، بسبب الخطوط الحمراء التي كانت موضوعة من قبل موسكو وواشنطن، لكن اليوم تدخلها يحظى بمباركة الطرفين معاً، فالأولى تعتبر أن دورها لا يمكن تجاوزه في محاربة الإرهاب، في حين أنّ الثانية تغطّيه عبر طائرات التحالف الدولي الذي تقوده، لا بل حتى لا يحظى بمعارضة شرسة من قبل كل من طهران ودمشق، بسبب المصلحة المشتركة في منع نشوء كيان كرديّ جديد في المنطقة.
من حيث المبدأ، باتت جميع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة تعترف بالدور الجوهري لأنقرة، على مستوى منطقة الشرق الأوسط، في وقت يتراجع فيه الجانب السعودي بشكل لافت، لا سيما بعد فشل الرياض في الحرب اليمنية التي تحولت إلى حرب إستنزاف لها، من دون أن يقدم أردوغان على دفع أثمان باهظة، فهو حتى اليوم لم يسحب دعمه لأي من فصائل المعارضة السورية المسلحة، وموقفه من الأزمة السورية على المستوى السياسي، لناحية عدم الإصرار على المطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد، كان قد بدأ بالتبدّل في وقت سابق.
وفي حين يعود البعض إلى الحديث عن أن الأهداف التركية في بداية الأزمة السورية كانت السيطرة على كامل البلاد، عبر التذكير بأن أحلام أردوغان كانت الصلاة في جامع الأمويين في دمشق، من الضروري العودة إلى المشهد الذي كان يسيطر على أنقرة قبل أشهر قليلة، حيث الأزمة مع موسكو على خلفيّة إسقاط المقاتلة الروسية، وتوتر العلاقات مع واشنطن بسبب أكثر من ملفّ، بالإضافة إلى الإتهامات التي كانت توجّه لها بدعم الجماعات الإرهابيّة، في حين عادت اليوم لتكون بوصلة الأحداث من جديد، موسكو لا تمانع دخولها العسكري إلى سوريا، ونائب الرئيس الأميركي جو بايدن يذهب إلى أنقرة لتأكيد الدعم وتقديم الإعتذار، في وقت تسمع فيه الثناء من الجانب الإيراني الراغب في إبعاد "السلطان" عن الدول الخليجية.
في المحصّلة، نجح رجب طيب أردوغان في تحويل الخطر الداهم إلى فرصة ذهبية، يعود من خلالها إلى اللعب على التناقضات لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، بالرغم من أن الأخطار التي تحدق به خلف ذلك لا تزال كبيرة، فهل يكون دفع الثمن مؤجّل؟