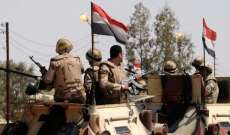عادت مصر لتتصدّر واجهة الأحداث مجدّداً، ليس بسبب تصاعد عمليات المسلّحين ضدّ الجيش المصري وآخرها العملية الكبيرة أمس في بني زويد شمال سيناء فحسب، ولا بسبب خطوات هادئة ومحسوبة تخطوها القيادة المصرية على طريق الاستقلال السياسي والاقتصادي والعسكري، بل ربما لأنّ مصر عادت لتحتلّ موقعاً مهماً في الخريطة العربية، بدءاً من ليبيا الى السودان وفلسطين وكلها دول مجاورة لها.
وحسب شخصيةٍ عربية عارفة بالأوضاع المصرية، فإنّ مصر تواجه كل هذه الضغوط التي تمارسها عليها قوى قريبة وبعيدة لإدراكها أنّ القاهرة إذا خرجت من القمقم الذي فرضته عليها يوماً معاهدة «كمب ديفيد» وسياسة الإعتماد على واشنطن، فإنّ المصري سيصبح حاضراً بكل قوة في تفاصيل الحياة العربية والإسلامية، وحتى العالمية.
ففي أيامٍ معدودة برز دورٌ لمصر في الشرق الليبي حيث إستقبلت رئيس حكومة طبرق عبدالله الثَني وبحثت معه في كل الوسائل التي تُمَكن الجيش الليبي من هزيمة المسلحين المتطرفين وإعادة الوحدة والأمن الى ليبيا الممزَقة.
وعلى رغم أنّ الحكومة المصرية تحرص على التأكيد أن لا تدخلَ عسكرياً في ليبيا، وأنّ جيش مصر يحمي مصر من داخل حدودها، فإنّ جميع المراقبين يلاحظون وجود «ملائكة» مصر في الربوع الليبية، كما في العلاقات مع الجزائر وتونس والسودان بغية كبح جماح الفوضى المنتشِرة في ليبيا ومنع شظاياها من الوصول الى عموم المنطقة.
وفي هذه الأيام نفسها استقبلت القاهرة الرئيس «الإخواني» عمر حسن البشير في خطوةٍ فاجأت كثيرين، خصوصاً بسبب الخلفية «الإخوانية» للرئيس السوداني وبسبب إتهاماتٍ للخرطوم بمساعدة جماعاتٍ إسلامية متطرّفة في مصر.
الإنفتاح المصري على السودان إذاً، كان وليد نضجٍ سياسيٍ لافت، فالتفاهم مع الخرطوم ضروري، وكذلك مع أثيوبيا لمعالجة المشكلات المتفاقمة في حوض النيل، وهذا التفاهم ضروريٌّ أيضاً لمُحاصرة التطرّف في ليبيا. فالسودان كان دائماً عمقاً استراتيجياً جنوبياً للأمن المصري، كذلك ليبيا تشكل عمقاً استراتيجياً غربياً لمصر، وبلاد الشام عمقاً استراتيجياً شمالياً.
وفي هذه الأيام أيضاً شهدت القاهرة مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار غزة بك ما ينطوي عليه من رسائل اقتصادية وسياسية واستراتيجية. ذلك أنّ إصرار مصر على استضافة هذا المؤتمر بعدما بادرت السويد الى عقده هو محاولة مصرِيَة لتذكير العالم بأنّ قطاع غزة على رغم فلسطينيته بقيَ نحوَ عشرين عاماً تحت الإدارة المصريّة.
وتقول هذه الشخصية العربية الواسعة الإطلاع إنّ جهداً مصرياً حثيثاً يُبذَل بغيةَ إنجاز حلّ سياسي للأزمة السوريّة، فالعلاقة بين عسكريّي البلدَين وأجهزتهما الأمنية لم تنقطع يوماً، بل كانت مصر في الوقت نفسه، خصوصاً بعد الإطاحة بحكم «الإخوان المسلمين» تحاول الموازنة بين أمنها الاقتصادي المرتبط بالرياض ودول الخليج وبين أمنها القومي الإستراتيجي المرتبط بدمشق وبيروت.
وتضيف الشخصية نفسها أنّ مَن يريدُ قراءة الدور المصري الحقيقي في سوريا يلمس بداياته في لبنان، وتحديداً في حلّ أزمة دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية إلتي إتفق على حلّها سياسيون موزَعون بين فريقَي 8 و14 آذار وبين العلاقة الجيدة مع دمشق والقاهرة والرياض. لكنّ السياسة المصرية ذات الخبرة المتراكِمة لا تهوى القفزَ في الهواء ولا تنقل قَدَماً شبراً واحداً الى الأمام إلاّ بعد أن تتأكد من ثبات الأرض تحت الأقدام.
وإزاء هذه التحوّلات المهمة في السياسة الخارجية المصرية جاءت تحوّلات ذاتَ بعدٍ عسكري واقتصادي بالغ الاهمية، فكان قرار توقيع صفقة أسلحة بقيمة 3,5 مليارات دولار مع موسكو خطوة أولى وإشارةً واضحة الى استقلال القرار المصري وحرصه على تنويع مصادر تسلّحه لكي لا يبقى عرضةً لابتزاز واشنطن وحلفائها وامزجتهم.
وكانت الخطوة الثانية نجاح الاكتتاب الشعبي في تمويل مشروع توسيع قناة السويس وتطويرها، فأقدم المصريون خلال أيامٍ قليلة على شراء شهادات استثمار بقيمة 60 مليار جنيه مصري، أيْ ما يعادل 8,5 مليارات دولار، وهو ما يفوق كلفة توسيع القناة التي لا تزيد عن 5 مليارات دولار، ليتمّ استخدام الفائض في تنفيذ مشروع مركز خدمات عالمي للسفن الماخرة في القناة التي تكون اصبحت أوسع وأكبر.
ولا يخفي الديبلوماسيون المصريون أنّ مشاريع كبرى تعِدّها القيادة المصرية ويموّلها الشعب المصري ويمكنها أن تنقل مصر من مرحلة الى أُخرى، فلم يعد المصريون قيادةً وشعباً يستسيغون دورَ المتسوّل من هذه الجهة أو تلك، فمصر كبيرة بذاتها وكبيرة بأمّتها.
هذه التطورات المهمة التي تشهدها مصر هي التي تفسر شراسة الهجمة عليها وعلى قواتها المسلحة والأمنية، وهي شراسةٌ لا يمارسها بعض المتطرفين فقط، بل تقف وراءها جهات إقليمية ودولية لا تريد الخير لمصر وتتربص بها شراً، وتعمل لمنعها من استعادة دورها الطبيعي في أُمّتها.