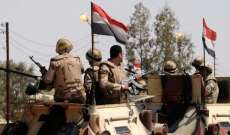من المؤسف أن يحبِسَ الإنسان أنفاسَه ويُقيّدَ رجاءَه ويحدّدَ مستقبلَه على أساسِ سِعة إهراءاتٍ موسَمية، من نفطٍ أو غذاء أو دواء، تَفرغُ أو تَطفو، على هوى الأيام والظروف العابرة!
ومن المؤسف أيضاً أن يعتقد الإنسانُ المواطنُ، بسبب فراغ تلك الإهراءات إلى حين، أنّ حياته قد انتهت أو أن وطنه قد «بات على مشارف الزوال».
منذ متى كانت حياة الإنسان تُقاس بما يَجمعُ من خيراتٍ أرضية، أو بما تُوفِّرُ له غلّاتُه من ضماناتٍ مستقبلية، أو بما يُتاح في وطنه والعالم من تسوياتٍ سياسيّة؟ لماذا انحدر مفهومُ الوجود والبقاء والإستمرارية، لدى المؤمنين بالله خصوصاً، إلى هذا المستوى الخطير من فقدان الثقة بالرب الذي قال يوماً للفقراء وفاقدي الهوية والكرامة والوطن والخبز والمال: «لا تقلقوا بشأن الغد ماذا سنأكل أو نشرب أو نلبس... بل أطلبوا أولاً ملكوتَ الله وبرَّه وهذه كلُّها تُزادُ لكم» (إنجيل متى، 6). هل هذا كلامُ شِعرٍ أم حقيقة؟
إذا كان هذا الكلام حقيقة، وهو كذلك، - ونحن في المقابل نعيش ونتصرف كلَّ يوم متجاهلين ومُتناسين لتلك الحقيقة - علينا حينها أن نقلق جدّياً على وجودنا ومصيرنا، لأننا سنكون في الواقع واقفين أمام مفتَرق خطير:
- إمّا أن نكون قد فقدْنا إيمانَنا بالله وأصبح كلامُه كاذباً في كل ما شَهِدَ له وعلّمَه،
- وإمّا أن نكون قد فرغنا من «مخزون الروحانية» الذي يغذّي إيمانَنا ويجعلنا «مستعدّين دائماً للإجابة عن سبب الرجاء الذي فينا» (رسالة بطرس الأولى، 3).
يبدو في الغالب أننا لم نفقد إيمانَنا بل فرغ قلبُنا من «مخزون الروحانية» والحِكَم السماوية. لقد أضحينا في غالبيتنا مؤمنين هَزيلين وأتقياءَ فارغين. روحانيتُنا أصبحت هَشّة، بلا مخزونٍ يُذكر، وغيرَ قادرة على أن «تشدّدَ أيادينا المسترخية، وتثبّتَ ركُبَنا المرتعشة» (أشعيا 35). نجاهرُ «بالغضب» تعبيراً عن سخطنا، بدل الرويّة والصبر والثقة بالله. ونشجّع بعضَنا على الثورة «مهما كان الثمن»، ونحن لا نجرؤ على مسّها بإحدى أصابعنا!
بتنا نبحثُ عن مكامن القِوى ومصادرها أينما كان وعند أيّ كان، إلا في صفاء قلوبِنا ونقاوةِ ضمائرنا. لقد ضَللنا طريقَنا «وأعداؤنا في ضيقنا يتفرّسون فينا وينظرون ولا مِن مُعين» (مزمور 22).
لقد تحوّلَتْ روحانيتُنا، من أولويةٍ يجب تغذيتها مما نُعطى من حكمة ونكتسب من برارة، إلى مجرّد فكرة مهمّشة ومنسيّة تنوء تحت أثقال الحياة اليومية وتَسَارُع الأحداثِ والأوقات، ولا من مرشد يَهدينا إلى طريق الحل ويختصر معاناتَنا. فكلُّ الطروحاتِ المتوافرة حالياً لتحريرنا من معاناتنا قد أضْحت، ويا للأسف، محصورةً بمنطق العالم الفارغ من صوت الله وسلامِه. إن الله وحده «وازنُ القلوب وفاحصُها» (أمثال 21).
فمخزون قلوبنا من الغنى الروحي يفوق بكثير أي ميلٍ يمكن أن يجنحَ بها نحو الشهوات والتعلّق بالماديّات. لذك أوصىانا الله بالعودة إلى القلب، أي إلى ذلك الخزّان الروحي السخيّ، سائلا كُلّاً منا أن يعطيَه إيّاه لكي يملأه من فيض حكمتِه وحُبّه: «يا بنيّ أعطني قلبك، ولتلاحظ عيناك طرُقي» (أمثال 23).
فمهما اختلفت الظروف وتبدّلت الأحداثُ وتصارعَت القوى، لا يختلفُ أحدٌ من أبناء وطني على حقيقة «مخزون الروحانية» هذا، والمشترك بالتساوي بينهم جميعاً أمام الله، بلا مزايدة أو تبجّح.
في المحصِّلة، صحيحٌ أن أبناءَ وطني قد خسِروا كثيراً من مقتنياتهم وخيراتهم، ويتقاسمون القلقَ على مصيرهم ومصير أولادهم، ويتسارعون إلى اقتناص الفرص على أنواعها لإنقاذ ما أمكن من سُبل العيش الكريم والمستقبل الآمن. ولكن، في المقابل، فإنّ الغنى الروحي الذي يخزّنونه في قلوبهم على مدى الساعات والأيام سيبقى، في البَحبوحة أو العوَز، الضمان الأقوى لثباتنا وقدراتنا على مواجهة الصعاب وتخطّيها. فما هو «غيرُ مُستطاع عند الناس، مُستطاعٌ عند الله» (إنجيل لوقا 18).